االإعلامى الكبير محمد جراح يكتب: المساكنة الإعلامية


تحدثت في مقال سابق عن المساكنة بمعناها العام، ومثلما أوضحت معانيها فقد ذكرت نماذج منها خصوصاً ما يتعلق منها بصور المساكنة بين الرجل والمرأة، وموقف الشرائع السماوية والإسلام منها؛ على الرغم من إباحة مجتمعات الغرب لها بحجة أنها تمهد للزواج، وهو فكر غريب على مجتمعاتنا الشرقية وشريعتنا الغراء. كما أشرت إلى المساكنة السياسية التي قد تعني ائتلافاً في الحياة النيابية والحكم، وأراني أنظر فأرى فأتساءل هل هناك ما يمكن تسميته بالمساكنة الإعلامية؟، إذا ما افترضنا وجود ما يمكن تسميته بالمساكنة الإعلامية فهل يعني ذلك أن تكون هناك مشاركة أو مزيجاً بين مدارس إعلامية تقود دفة الإعلام في دولة ما ولتكن دولتنا الحبيبة مثلاً؟
وقبل الإجابة على هذا الفرض يجدر بي أن أعود قليلاً إلى الوراء، ولنبدأ من عام 1952م وهو العام الذي شهد قيام ثورة يوليو المجيدة، وإذاعة بيان الثورة من وسيلة الإعلام الأحدث والأسرع في ذلك الزمن وهي الإذاعة. والملاحظ للحراك الثوري في الخمسينيات يجد أن الدولة ممثلة في البداية في مجلس قيادة الثورة قد أولت الإذاعة أو الإعلام المسموع جل عنايتها باعتبارها الوسيلة الأسرع في الوصول بالرسالة إلى المتلقين من الجماهير، ومن أجل ذلك عملت على تحديث الاستديوهات، وتقوية الموجات، بل بإطلاق خدمات إذاعية جديدة بين الحين والأخر مثل إذاعات الاسكندرية المحلية، وصوت العرب، ومع الشعب، والبرنامج الثاني، وغيرها وصولاً إلى إذاعتي الشرق الأوسط والقرآن الكريم في الستينيات من القرن المنصرم.
ولم تتأخر الدولة في إطلاق إذاعتها المرئية أي التليفزيون الذي انطلق بثه الرسمي مع الاحتفالات بعيد الثورة في يوليو من عام 1960م، ودأبت على رعايته، وتحديث أدواته وأجهزته بين الحين والآخر، ولا يعني اهتمام الدولة بالإعلامين المسوع والمرئي أنها أهملت الإعلام المقروء، فقد صار للدولة جناحان أحدهما مسموع؛ والآخر مرئي، ومع الجناحين جسد ينبض بالحياة والحركة هو الصحافة المقروءة. وكانت الصحافة قبل ثورة يوليو تتمتع بقدر كبير من الحرية، وكان بإمكان أي كاتب أن يكتب ما يشاء، وينتقد ما يشاء من دون أن يمر رأيه على رقيب وإن لم يخل الأمر من تدخلات ومضايقات كانت تصل إلى مصادرة الصحف وإغلاق الدور الصحفية؛ بل وحبس أصحاب الرأي وعلى سبيل المثال حبُس الكاتب الكبير عباس محمود العقاد لما أبدى رأيه في قانون محاسبة الوزراء في مجلس النواب، كما حبس امبراطور الصحافة المصرية محمد التابعي وغيرهما، وكان هامش الحرية يتيح للكاتب الحصيف أن يراوح في منطقة الهامش تلك بما لا يوقعه تحت طائلة القانون، ومن ثم يسلم من المساءلة.
غير أن حكومة الثورة ومنذ اليوم الأول لمجيئها نظرت فرأت ألا يعلو صوت فوق صوتها فأخضعت الصحافة المقروءة لإشرافها، وسارعت فأنشات صحفاً تعبر عنها وتنطق باسمها، ثم رأت في خطوة أخرى تأميم الصحافة فأصبحت الدور المتبقية تابعة للحكومة مثلما كان الحال في الإذاعة التي كانت لا تنطق بغير لسان الحكومة، وعلى شاكلتها جاء التليفزيون، وبالطبع كان ولاء رؤساء التحرير للحكومة كاملاً باعتبارها المالك لتلك المؤسسات، ويعبرون عن وجهة نظرها لا أكثر، وهي أيضاً التي تعينهمن ومن ثم لم تمنح أي هوامش لحرية الرأي أو النقد طوال الفترة من عام 1952م وحتى وفاة عبد النصر في سبتمبر عام 1970م.
وفي فترة حكم السادات استمر الحال على ما هو عليه حتى تمت الموافقة على قبام الأحزاب، وصار من حق كل حزب أن يصدر صحيفة، وقد أحدثت تلك الصحف حراكاً في المجتمع لما تميزت به من طرح مختلف، ونقد مباشر أثار حفيظة أُولي الأمر في غير مرة، وعرّض الكتاب للمضايقة بشكل أو بآخر، واستمرت المسيرة الصحفية وصحف الأحزاب ثم الصحافة الخاصة في عصر مبارك وحتى قيام ثورة يناير من عام 2011م، وإذا كانت الصحف قد استمرت بعد يناير 2011 م؛ إلا أنه يمكن القول إن الوسائط الحديثة نالت من الصحافة بل إن ما تبقى من الصحافة صار مراقباً ولا يخلو من التعرض للمضايقة وربما الملاحقة.
كان هذا بالنسبة للصحافة المكتوبة فماذا عن الصحافة المسموعة والمرئية؟، الإجابة لا جديد حتى مع انطلاق القنوت الفضائية العامة والإخبارية فقد ظلت في البداية لا تختلف عن القنوات الأرضية، ثم جاءت فترة اطلاق القنوات الخاصة المملوكة لأناس أكثرهم إن لم يكن كلهم من رجال الأعمال، وقد أصبح لكل قناة من تلك القنوات برنامج رئيس يطلق عليه مجازاً مسمى "توك شو"، وكانت مساحة الحرية والجرأة في تلك البرامج غير معهودة من قبل، وعلى سبيل المثال التف المشاهون حول التلفاز لمشاهدة معتز الدمرداش في برنامج 90 دقيقة بقناة المحور، ومنى الشاذلي على قناة دريم وبرنامج العاشرة مساء، وأصبحنا في العشرية الأخيرة من حكم الرئيس مبارك نشاهد برامج بها من الجرأة ما لم نعهده من قبل، وبالطبع كان هامش الحرية ذاك لا يطول أجهزة الدولة وخصوصاً السيادية منها، أي أنه كان هناك ما يمكن اعتباره خطاً أحمر لا يتخطاه مقدم البرنامج، وقد حافظ مقدم كل برنامج على التوقف دون ذلك الخط، وكان الرقيب الذاتي أكثر قسوة على أصحابه من ذلك الرقيب الذي ظل الجميع يخشون الاحتكاك به!.
وفي المقابل أطلق التليفزيون المصري برنامج التوك شو الخاص به والذي استطاع المنافسة مع برامج الفضائيات الخاصة، وكان له الحضور الجيد على الساحة، وتولى أمر تقديمه وافدون على ماسبيرو بحجة الإعلانات، وبمشاركة كيانات أخرى من خارج ماسبيرو حتى تدهور الحال مع اندلاع أحداث يناير 2011م والتشويه المتعمد لماسبيرو والإصرار على تركيعه لسحب البساط من تحت قدميه، وهو ما حدث للأسف؛ ومن يومها وعلى الرغم من كل محاولات إفاقة ماسبيرو إلا أنها كانت كلها إفاقات وقتية فسرعان ما كان ماسبيرو يعود بعدها إلى سباته.
وقبل أن اعود للحديث عن ماسبيرو يجدر بي وفي عجالة الإشارة إلى أن بعض الدول العربية وخصوصاً بعض دول الخليج استطاعت في سنوات متعاقبة بدأت مع أواخر التسعينيات من القرن الماضي؛ وزادت مع مطلع الألفية الثالثة من اطلاق قنواتها الفضائية في أثوابها المختلفة من القنوات العامة والمنوعة إلى القنوات الإخبارية القوية، وعلى سبيل المثال بدات السعودية بقنوات ART أيه آر تي، ثم بقنوات MBC إم بي سي ثم بالقناة الإخبارية المتخصصة وهي قناة العربية ثم العربية الحدث ومعها قناة الإخبارية وغيرها، ومن قطر انطلقت قناة الجزيرة الإخبارية التي جاء ميلادها مع حرب تحرير الكويت وقد ولدت قوية واستمرت، والأمر نفسه حدث في الإمارات التي أطلقت قناة سكاي نيوز عربية وغيرها من القنوات المتخصصة.
وقد شهدت السنوات الأخيرة من تسعينيات القرن الماضي مولد قطاع النيل المصري للقنوات المتخصصة فأصبح هناك قنوات للمنوعات والأطفال والرياضة والثقافة وغيرها، وبالطبع تم إطلاق قناة النيل للأخبار، وعلى الرغم من كل محاولات تحديثها؛ وإعادة إطلاقها؛ والاستعانة بخبرات إنجليزية إلا أنها لم تستطع أن تكون منافساً لقناة الجزيرة ولا لقناة لعربية ولا حتى لسكاي نيوز، وظلت القناة منذ إطلاقها وحتى الآن تائهة لا لقصور في مذيعيها، ولكن لضعف إمكانياتها، والقيود التي تكبل متخذ القرار والتي تصل به إن فكر في تجاوزها إلى المساءلة التي من الممكن أن تطييح به، أو تصل به إلى أعتاب السجن كما حدث مع المهندس أسامة الشيخ الذي حاول أن يستنهض صناعة الدراما حتى وجد نفسه محبوساً؛ وظل به لفترة في محبسه قبل أن يسترد حريته ويحصل على البراءة مما نسب إليه.
وبعد هذا العرض السريع أعود إلى مصطلح المساكنة الإعلامية، وأعاود السؤال: هل استطاع من يدير منظومة الإعلام المصري الاستفادة مما هو متاح له؟، هل استطاع حسن إدارة المنظومة؛ أم انه وقع فريسة للبيروقراطي،ة واكتفى وهو يعتلي كرسيه أن يكون رئيساً موظفاً لا رأي مغاير لرأي من يعلونه في الهرم الوظيفي حتى لا يثيرهم ويجلب على نفسه المشاكل؛ ويفقد في ساعة طيش منصبه الذي يحسده عليه غيره بما يحصل عليه من امتيازات ووجاهة اجتماعية.
وكان من نتاج ذلك الفكر العقيم أن تراجعت صناعة الإعلام في مصر، ودخل علينا الغرباء من الأبواب والشبابيك حتى فتحنا لهم مصطرين الأبواب، فانصرف المشاهد بشكل أو بآخر عن إعلامه إلى إعلام بديل يلبي له حاجته من المعرفة، ولأن لكل وسيلة رسالة وهدف فقد تسممت عقول الكثيرين من المتلقين من الرسائل التي تبثها مثل تلك القنوات مع مادتها ومحتواها، فكل ما يبث يتلون بسياسة القناة مهما حاولت أن تدعي الحياد والمهنية، فغسلت الأدمغة، وأصبح أمر استعادة ذلك المتلقي سواء القارئ أو المستمع أو المشاهد من الصعوبة بمكان وهو ما يتطلب بذل الكثير والكثير مالاً وفكراً وتخطيطاً، فالإعلام صناعة مكلفة، والدولة الأولى في العالم أي الولايات المتحدة الأمريكية تعيش عصر الدولة الإعلامية بعد ان امتلكت كل أسباب قوتها، وقد يكون من المهم تناول شأن ما مر بالتجربة الإعلامية المصرية وما شابها من قصور في المقال القادم من المساكنة الإعلامية..






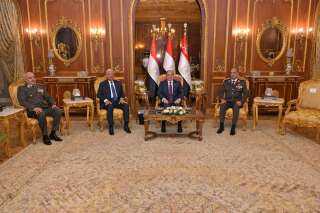





 زوج ييشعل النار في زوجته قبل موعد الإفطار بدقائق
زوج ييشعل النار في زوجته قبل موعد الإفطار بدقائق دعوى قضائية تطالب بوقف نشر صور المتهمات والقاصرات فى قضايا الآداب
دعوى قضائية تطالب بوقف نشر صور المتهمات والقاصرات فى قضايا الآداب مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران مع الداخلية...
مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النيران مع الداخلية... تأجيل محاكمة 139 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 9 مايو
تأجيل محاكمة 139 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 9 مايو اسعار الذهب اليوم الأحد فى محلات الصاغة
اسعار الذهب اليوم الأحد فى محلات الصاغة أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 - 2 - 2026
أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 - 2 - 2026 أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يقفز 40 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يقفز 40 جنيهًا ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 7200 جنيه الجمعة...
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 7200 جنيه الجمعة...