د.حسين التكمة جي يكتب: الفكرة الدرامية بين السمو والتدني


يعد ( أرسطو ) أول من وضع مفهوما للفكرة , بوصفها أحد أهم ركائز الدراما, ومنذ ذلك الحين لم ينفك هذا المفهوم ثابتا ولم يجرأ أحد على نقضه ,,كونه يؤطر الموضوع ويستجلي المعنى , كما أن المخرج المسرحي هو الأخر تبنى هذا المفهوم في بنية العرض الدرامية , وتتأتى أهميته حينما تسعى جميع العناصر مجتمعة لتوكيده ،بدْءا بالفعل والأزمة والحبكة والعقدة والذرة وأخيرا الشخصية, التي هي مركز تفجير الفكرة أو
( الثميه ) .وقد وصفت كونها من القواعد الصارمة التي ينبغي الالتزام بها من قبل المؤلف والمخرج معا ,حتى وصفها شلدون تشيني "بأنها وضعت بشكل قسري " (3) فضلا على ما أطلق عليه الوحدات الثلاث . *
والفكرة هي خلاصة تؤطر الفهم الكامل للنص الدرامي، أو أنها العامل المشترك الأعلى للنص الدرامي أن جاز لنا التعبير أو هي وجهة النظر الذاتية أو الموضوعية التي يبني المؤلف نصه الدرامي على أساسها، قد تتلخص في كلمة واحدة تحمل المعني كما هو الحال في مسرحية عطيل (الغيرة) و(الجشع) في تاجر البندقية وقد تأتي بصيغة جمله مفيدة شاملة للمعنى (التراكم الكمي يولد وعي نوعي) عند بيتر فايس، و(يرث الأبناء ما تركه الآباء) في مسرحية الأشباح لإبسن.
فهي أذن هي المغزى أو المعنى الأساسي الذي يعد محور العمل الدرامي، وهو ما يرغب أي كاتب أو مخرج من ايصالها الى الجمهور.
ولذا يلخص العرض المسرحي بكلمة أو جمله، وهي ليست قصة المسرحية أو الحكاية. فالفكرة لها خاصية الانتشار ضمن حبكة النص الدرامي وصولا للأفعال التكنيكية الصغيرة، والتي من خلالها يحصل بناء التوتر من المشهد الاستهلالي حتى الذروة التي يطرح المؤلف فيها الفكرة أو الثيمة، بوصفها " تنطوي على وجهة النظر أو الغاية التي نتلقاها" ( 4) .
وصياغة الفكرة تنطوي على استرداد ذهني في الأدراك الحسي وعلى فهم دقيق لكل ماهية النص الدرامي، ذلك ان المتخيل الذهني أو الخيال الخصب لدى الكاتب يمر بسلسلة من السرحان الطويل والتفكير العميق لبناء الفكرة أو الثيمة حتى يصار الى التجلي الذي هو الفكرة الأساسية، حينها يبدأ الكاتب من توزيع وحداتها بشكل أفعال حوارية او كلامية وحركية وبيئية ومكان واستحداث الشخصيات لتحقيق قيام الفكرة.
والفكرة ليست الحكاية أو القصة، إلا أنها تشكل الحبكة والعقدة والشخصية حتى نهاية العرض بحيث تبدو الفكرة واضحة وجلية ومفهومة من قبل أكثر الناس.وللسبب ذاته تعددت وجهات النظر بين فلسفية واجتماعية وفكرية ودينيه
وموضوعية، مما أفرز اختلافا في تنوع(الفكرة)، ويرى بعض النقاد أن قيمة الفكرة والثيمة، تتأتى في قيمتها "بأن كل مسرحية يجب أن تقوم على فكرة منطقيه، يحاول الكاتب أن يبرهن عليها بالأحداث والشخصيات "(1) .
مما دفع الباحثين والنقاد إلى دراسة البناء الدرامي بشكل تفصيلي ودقيق، لفهم البنية الدرامية وصولا للفكرة، فقد قامت مجموعة من الباحثين السوفييت َفي نظرية الأدب بمعية (م . س. كوركنيان) بدراستها بشكل علمي مؤكدين " أن الدراما تقوم على أفعال سبقت النص الدرامي أطلقوا عليها (الوضعية الأساسية) واعتبروا أن كل حالة من حالات الحدث تكاد تتغلغل في الوضعية الأساسية "(2).
على وفق دراستهم لنص لأوديب ملكا، إذ كانت تسبقها أحداث وقعت خارج النص، والعرض والنص يفتح مغاليق ومؤكدات تلكم الأحداث ( الكشف ) وصولا للفكرة أو الثيمة الرئيسة بعد معرفة الحقيقة من قبل أوديب , ذلك أن " الحدث الدرامي يستدرج التمهيدية المتقدمة بحيث تصبح جزء لا يتجزأ من هذه اللحظة
( الفكرة ) الخاصة بالحدث الدرامي "( 3).
وبهذا تصبح الفكرة هي الحل الشامل والجواب الوافي والموعظة التي يستنتجها المتلقي من وراء النص. ويذهب (هيجل) في معالجته للفن " إن محتوى الفن هو الفكرة التي تصاغ في شكل محسوس .... وأن الواقع المصاغ بشكل يناسب مع مفهومه هو المثل الأعلى " ( 4) .
أستمر الحال على استخدام تلكم القواعد الصارمة حتى ظهور الكلاسيكية الجديدة عند
( راسين وكورني ) .وعلى الرغم من وجود تصادمات فكرية حول ما جاءت به الكلاسيكية ومفاهيم
( أرسطو ) إلا أن الكتاب الدراميين التزموا بها أشد الالتزام , ولما كان الكاتب المسرحي أو المؤلف , هو المخرج في الفترة التي سبقت ظهور المخرج , فقد كان مولعا بأن يضع الكثير من الملاحظات بين أقواس أو أنه يحاول أعطاء فكرة الجو لعام والمناظر قبل المشاهد والفصول أو وضع ملاحظات بين الحوارات للحالة النفسية والأدائية للممثل , مما كان الالتزام بها واجبا , ولعل العودة إلى النصوص القديمة نتلمس ذلك بوضوح , وعلى وفق ما تقدم التزم المؤلف بكل هذه التوجيهات كما التزم بالقواعد التي يتوافر عليها النص ,ومن هنا يمكن القول أن المؤلف( مفسر ) للنص , لا يقدم أي إضافة أو حذف لضرورات فنيه , كونها تسيء إلى الثيمة وتؤدي إلى فشل العرض . هذا الالتزام أستمر حتى فترة ظهور المخرج، والذي قدم بدوره أراء جديدة في عصر النهضة ومفهوما آخر للفكرة، حينما وجدوا أن
( الفكرة تلازم المضمون) * بل وتسعى إلى تحقيقه من خلال تنامي الفعل الدرامي، بوصفه خط التواصل بين الأحداث والثيمة، ولما كانت ثيمة مسرحية (ماكبث) (الاستحواذ على السلطة بلا رحمة) فإن الأفعال التي يقوم عليها البناء الدرامي تتصف بالسلوكية الخاصة بالشخصية ورغبتها الشديدة في السلطة حتى وأن
كان ذلك على حساب الآخرين، حتى مع من يحبه ويرفع شأنه (الملك دنكان)، هكذا يسقط ماكبث في بئر جشعة وطمعه. في حين تذهب مسرحية (بيت الدمية) لإبسن وفق ثيمة (عدم المساواة بين الزوجين يخلق التعاسة) تؤطر المرحلة الاجتماعية للثورة الصناعية ومشاكل الحريات النسائية. والأمثلة على ذلك كثيرة.
الحقيقة أن ما يجعل هذه الثيمات مستوفية لشروط الحضور المسرحي، هو ملاحقة الأفعال المدججة بالتفاصيل الدرامية ومن خلال الحدث، وكذلك المثيرات الحسية والفكرية ذلك لكون الفعل في المسرح هو " الحركة العامة التي تسير بشيء ما، يولد وينمو، ويموت، ما بين البداية والنهاية “(1)
وعلى وفق ما تقدم يصبح المتسيد من الأفعال هو المعول عليه لكونه يصب في مجرى الفكرة أو الثيمة، من كونها تأتي في نقطة التوتر والذروة، كما أشار لها (أرسطو).
فالفكرة أو الثيمة العميقة تؤتي توترات عدة وتساهم في خلق الشد والترقب المتواصل لحين انكشاف الأمر وتجليه، كما أنها تحاكي عصرها وموقفها الاجتماعي وتزيد من فهم الظاهرة أو تطرح مفهوما جديدا
أوجدته الضرورات أن كانت (دينيه أو اجتماعية أو سياسية. ومن هنا أصبح عمل الدراما ليس السرد ولا " تجزئة العملية الوصفية إلى أسئلة وأجوبة، بل في الاختيار الشديد الحذر لتلك المؤتلفات الخاصة بهذه العملية الوصفية “(2).
في حين أن الثيمة البسيطة تنطوي على فعل بسيط وأحداث ربما تكون ساذجة وبديهية أو ضعيفة.. مما يهدم البناء الدرامي في النهاية، ولكيلا تكون كذلك عمد أرسطو إلى وضع قانون الصراع الذي يحكم التوترات والشد ويساهم في تعقيد المشكلة والأزمة وصولا للذروة.
يمكن القول استنتاجا، أن أي نص رامي يستدعي توافر الفكرة أو الثيمة " التي يتبناها المؤلف ويدافع عنها سوى أخفاها أو أبانها، فهي طرح جديد " (3).
بات الحال كما هو علية حتى ظهور فن الإخراج المسرحي، وبقيت الطريقة سائدة في التقديم من الكلاسيكية وحتى عصر النهضة، حينما توفرت للمخرج ن يكون قادرا على أدارة عملية الإخراج، في حين كان الكاتب المسرحي مشاركا لعملية الإنتاج بمعية المخرج، كون الخشبة المسرحية قد اغتنى وجودها بوجود المخرج.
وبعد الظهور الفني لعمل المخرج الذي أنيط بـ (جورج الثاني) عام (1826)، “ففي أول مايو 1874, قاد فرقته الناشئة ... إلى برلين ليقدم أول مسرح في أوربا يعرف بمسرح المخرج " (4) يعد عمل المخرج هنا بمثابة سبك النص في صورة تشكيلية وبشكل محدد، فضلا عن تدريب الممثل ودراسة المنظر وتجميع العرض بوحدة فنية متكاملة، ومع نهاية القرن التاسع عشر، صارت الحاجة ماسة لرجل الإخراج الذي استولى بدوره " على الفكر الذي أستكن بالكتاب (المؤلفون) في مزج فنون مختلفة في صور عضوية. حتى جاءت أفكار (جوهان دولف كا نك) حينما سيطر في نهاية القرن على تقنيات الفن الحديث للإخراج، مستغلا المعارف الأدبية والتجارب مشترطا على (المخرج) ألا يسمح لنفسه بأن يفعل شيئا لا يستطيع فعله بالمسرحية "(5).
هذا الأمر يؤكد أن العمل جماعي بمعية المخرج، كما أنه يؤكد من جانب أخر أهمية المخرج وسلطته على النص، غير أنه بمعية المؤلف سوف يلتزم بكل التفاصيل دون إضافة أو حذف، وقد بقي ألمخرج ملتزما بقواعد النص وتحقيقها ونقل أفكار المؤلف للمتلقي عن طريق الممثل والمحافظة على وجهة نظر المؤلف الذاتية والموضوعية، ومن هنا صار المخرج المسرحي رغم أهميته، مخرجا (مفسرا) للنص الدرامي، يمكن له فقط أن يدخل مداخل إبداعية على الجو العام والخدع والأزياء والإضاءة والمنظر المسرحي حتى ظهور المثاليين الجدد حينها ظهر مفهوم ( المخرج المبدع) بوصفه مؤلف ثاني للعرض .
وهذا ما سعى إليه المخرجان (أندريه أنطوان في الطبيعية) و (ستانسلافسكي في الواقعية) ، وما يميز اندريه أنطوان في الطبيعية " إلزامه في الدفاع عن الكاتب والمسرحية، والتفسير ونقل شريحة من الحياة أو النقل الفوتوغرافي للواقع، كما هو على خشبة المسرح وتوكيده للجدار الرابع “ (1)
في حين أن ستانسلافسكي لم يختلف عن سابقيه حينما أضاف بعض التحسينات على الإخراج يضمنها الواقعية النفسية والدقة التاريخية ومسرحة الواقع كما انه " لا يستطيع أن ينتج مسرحية ما لم يستخرج أولا فكرتها الأساسية، ولا يبني مسرحية على الأفكار والحيل الذكية " (2) .... وعلى أثر ذلك أعتمد ستان على جهده مع الممثل وأن يقدم سكربت للإخراج وان يوفر" نظرية جديدة في الإخراج المسرحي تقوم على المنطوق التالي (الفعل المتغلغل والفكرة الحاكمة أ ساس عملية الإخراج " (3 ).
نستنتج من ذلك أن الفكرة الحاكمة أو الثيمة هي الأساس ألنشوئي لفن الإخراج، ولا يأتي تحققها إلا باكتشاف وملاحقة الفعل الذي يتغلغل في حيثيات النص وملاحقته، ويرى أيضا أن الممثل أداة مهمة لنقل أفكار المؤلف والمخرج معا، ولهذا سار جل طلبته على نهجه وطريقته بالتزامهم بتقليد أستاذهم أمثال ( تايروف وأخلبكوف , وبوبوف ).
ولكون فلسفة العرض تطرح آنذاك هذا التوجه، وتؤكد أن المسرح يقوم على متعتان هما الحسية والفكرية، لكون القيمة الجمالية هي نتاج القيمتان العاطفية والفكرية. وربما للسبب ذاته لم يجرأ المخرج أن يمس الثيمة المجاورة واكتفي بحيثيات النص الذي أمامه وفكرته الأساسية حتى ظهور الرمزيون.
وبالرغم مما قدمنا له كان المؤلف حريصا على أن تفهم فكرته، فقد ترك لنا الأولون نصوصا ما زال المخرج يتجاوب معها، كونها مازالت تحوي على أفكار وثيم مجاورة تحاكي عصرنا الراهن، بالرغم من كونها كتبت لعصرها، إلا يعني هذا هو أنجاز يخفي تحت طياته ثيمات وليس ثيمة واحدة، ما هو السر في ذلك؟ ...فقد اكتشف بعض المخرجين أن هناك فكرة مخبئة بالنص دون الفكرة الأساسية، فحاولوا اقتناصها وتفعيلها دون الاهتمام بالفكرة الأم، وذلك ما دعي بالتيمة المجاورة .
وعلى وفق ما تقدم أصبح للمخرج حرية الاختيار والاقتناص الدقيق للتيمة، فأقدم على إضافة تحسينات وإجراءات على النص الدرامي وفق محاور، أما بالأعداد لنص جديد يخدم المضمون الفكري، أو ابتكار نصوص جديدة تتلاقح من بعيد مع النص الأصلي، وإما بوجود نصوص متعالقة مع نصوص سابقة غيرت ثيماتها الرئيسية إلى ثيمات أخرى.
كما هو الحال مع (ماكبث) صلاح القصب، أو (دزدمونه) ليوسف الصائغ، أو
( عطيل في المطبخ) لسامي عبد الحميد، فهي قراءات جديدة ورؤى مستقبلية وآنية فاعلة في البحث والتقصي، وأهمية البحث بين سطور النصوص عن ثيمات مجاورة كانت مخفية وغير مفعلة أصلا، حينما لم يكن يسمح للمخرج سابقا بتفعيل دورها.
ولعل القراءة المغايرة للنص هي التي فتحت الباب على مصراعيه لاقتناص ثيمات مجاورة. ويرى مارتن أسلن " إن الدراما ذات أبعاد متعددة (فيزيقيا)، فيمكن أن تحدث عدة أمور في الوقت ذاته " (1) .
فيمسي النص الدرامي معرض لعدة تساؤلات لغرض البحث عن ثيمات مجاورة للتيمة الأصلية، ولكونه ناقدا وباحثا في الدراما فهو الأخر يتساءل حول مسرحية هاملت لوليم شكسبير، "أن صلة هاملت بوالدته يمكن أن نعلق عليها اليوم، باعتبارها عرضا حقيقا عميقا لعقدة أوديب، ..... فالعلاقة بين شاب وأمه علاقة شك " (2).
وهو ما يدفعنا للقول إن (في انتظار كودوا) غياب واضح وحضور مادي مغيب ربما يكون له نفوذ سياسي في أماكن أخرى من العالم بوصفها تعالج الآمال المحيطة والانتظار للخلاص بدلا من عبثية الحياة.
والحال ربما يخص مسرحية (الأم شجاعة) لبرشت، فقد يتناولها المعسكر الاشتراكي بوصفها تاجرة حرب، وهي مدانة بوصفها فقدت أبنائها بسبب موقفها وبحثها عن المال، في حين يرى المعسكر الرأسمالي أن لها كل الحق في العمل من أجل الحصول على المال لبناء حياة الرفاهية. وعلى هذا النحو راحت السينما السوفيتية تجد عدة تفسيرات لقتل عطيل دزدمونه , عدى الأسباب التي صممها شكسبير والتي تتمثل
( بالغيرة ) فقد رأى البعض أن قتلها جاء من خلال اختلاف اللون والجذر العائلي , وأخر وجد أن عطيل عاجز جنسيا , فعمد إلى قتلها , بالرغم من أن شكسبير لم يكن فاشلا أبدا , بل كان في قمة النجاح لكونه يمتلك أعلى درجات الصدق والمهارة في إنتاج المعنى , غير أن وجهات نظر التناول جاءت مختلفة وراحت تبحث عن المخبوء من الثيم لتحاكي روح العصر , وقد جرى الحال على العديد من المسرحيات ( كتاجر البندقية و روميو وجوليت , و ماكبث , وبيت الدمية والعديد من النصوص ) .
فتاجر البندقية الذي عمد المؤلف بإظهار شخصيته المنطوية على الجشع وحب المال
والبخل، عمد أحد المخرجين إلى جعلها مسكينة ومغلوبة على أمرها، وأرجأ سبب ذلك إلى المجتمع الذي ساهم بجعلها بهذه الصورة، وتذهب مسرحية الأشباح لتوكيد ثيمة مبدأ الوراثة،
( بأن الأبناء يرثون ما حمله الآباء) فقد افرد أحد المخرجين أن سبب المرض الذي يعاني منه الابن هو (الإيدز) بالرغم من أن عصر النص الفعلي ينفي هذه الحالة لعدم وجود المرض آنذاك بالمرة.
ولم يكن المسرح العراقي بعيدا عن تلكم الرؤى، فقد أفاد من ذلك الكثير، فقدمت مسرحية
( هاملت عربيا وعطيل في المطبخ، وماكبث وديدمونة) كتوجه لٌتناص ثيمات مجاورة، ويرى صدقي خطاب " إن أخفاق ماكبث في قتل فليانس أبن بانكو، هو الحادث الذي أدى بالنهاية إلى سقوطه " (3). في حين قدمه صلاح القصب، بوصفه قاتلا في كل العصور، فشخصيته هي صور جديدة ومكررة لكل القتلة في كل العصور، وهو ما لا يتفق تماما مع النص الشكسبيري.
وعلى وفق ذلك يؤكد (كير أيلام) بأن " الخصائص الجوهرية المنسوبة إلى (الإنسان) تتعرض لتبدلات جذريه من ثقافة إلى أخرى ومن حقبة إلى أخرى، كما يحصل بالنسبة إلى العوالم التي تتحدد بأنها واقعية وممكنه " (4) .
وعلى أساس القاعدة السيمائية أعتبر النص حامل لعوالم جديدة أخرى تساهم في فرز ثيمات أخرى مجاورة، بالخصوص في النصوص المكتوبة " بفرضية إمتاعيه، إذ يؤلف هذا التأويل الأقناعي ثيمة جديدة وحكاية جديدة، وإذا لم يدرك المتلقي بأن التأويل إقناعي، فقد يخطئ ويحسب أن الدراما حقيقية " ( 1).
في الجانب الأخر يطالعنا موضوع الرؤية للتيمة المجاورة فالرؤية تتحدد بوجهة النظر وبناء الفعل وانعكاساته الفكرية على المتلقي، كما ينبغي الدقة في التعامل الدلالي لعدم تشظي الأفعال بغياب استظهار الثيمة، من خلال تفعيل دور الدلالة والعلامة والإشارة، فالرؤية ترجمة الدوالي إلى صورة بصريه مفعمة بالحيوية والمعنى، :" فالصورة إنتاج للخيال المحض، وهي بذلك تبدع لغة، وتعارض المجاز الذي يخرج اللغة عن دورها الاستعمالي " (2). وتأتي الرؤية من وجود شكل في المخيلة يسعى للتحقق، أي صورة مجردة، مما يتيح للمخرج مهمة استظهارها مرئية على الخشبة، وهنا تصبح عين المتلقي هي النافذة في إدراك الصورة وقراءة المعنى.
أن الفكرة الدرامية هي النشوء الأول للنص الدرامي ، بل هي المفتاح لكل ما يأتي ، فإن فرغت الدراما من فكرة سامية واتجهت نحو فكرة متدنية فذلك من شأنه أن يحقق الهبوط التام في المجال الدرامي على مستوى المسرح والسينما ، وأن ما يواجه المسرح اليوم امام جماهيره ، هو عدم فهم الجمهور لما يريد المخرج والمؤلف من قوله ، أن المسرحية تبدو مبهمة ولعل ذلك ما يدفع المتلقي للبحث عن أجوبه ، ( ماذا أراد المخرج أن يقوله لنا ؟ ) ، لقد كانت الدراما منذ البداية مسرح أفكار ،وأفكار عليا تسمو نحو ناصية المعرفة المغمسة بمعاناة الأنسان ، وليس مجرد أفكار هامشية تبدو استعراضية خالية من المعنى والفكر، فالفكرة الأساسية هي عصارة الذهن البشري وهي القدحة الذهنية الأولى في قيام الدراما ، وأن مهمة المخرج تفكيك النص وأعاده صياغة الدراما بحيث تبدو مسموعة ومرئية في آن واحد حاملة للمعنى دون اسفاف أو عدم فهم ، فالفكرة الأساسية هي ما يعول عليه كليا في بناء الدراما في المسرح والسينما وهي القوة التي تفجر أفعال العرض السمعية والبصرية والحركية على حد سواء .












 القبض على متهم بالتعدي على مسنة أمام مسجد بالمحلة الكبرى
القبض على متهم بالتعدي على مسنة أمام مسجد بالمحلة الكبرى ارتفاع ضحايا حادث تصادم بمحور 30 يونيو في بورسعيد إلى 18 وفاة...
ارتفاع ضحايا حادث تصادم بمحور 30 يونيو في بورسعيد إلى 18 وفاة... ضبط 433 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
ضبط 433 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الداخلية تضبط أكثر من 101 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
الداخلية تضبط أكثر من 101 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 - 2 - 2026
أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 - 2 - 2026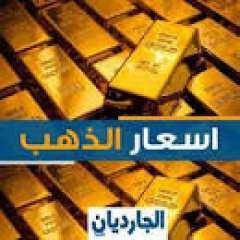 أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يقفز 40 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يقفز 40 جنيهًا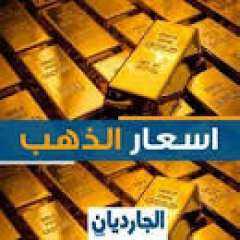 ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 7200 جنيه الجمعة...
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 7200 جنيه الجمعة... الدولار ينخفض 5 قروش أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري بالتعاملات الصباحية
الدولار ينخفض 5 قروش أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري بالتعاملات الصباحية