دكتور علاء الحمزاوى يكتب : حُبُّ التَّناهي شَطَط خَيرُ الأمورِ الوَسَط


ــ هذا العنوان حكمة من حِكَم العرب، والوَسَط الاعتدال، والتناهي بلوغ الشيء منتهاه وهو الغلوُّ، والشطط الإفـراط والتجاوز والحَيْف والمَيْل والظلم، وبهذه المعاني ورد في القرآن ثلاث مرات: في قوله تعالى: {فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا}، أي لو دعونا أحدا غير الله فقولنا حينئذ شطط أي ظلم وانحراف عن الحق، وفي قوله تعالى: {قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ} أي احكم بالعدل ولا تَمِل فتنحرف فتظلم، وهذا القول من المدَّعي للقاضي أو الحاكم يدل على حرية التعبير آنذاك، وفي قوله تعالى: {وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا} السفيه المشرك من الجن والإنس، والشطط الغلو في قول الكفر.
ــ والمعنى الظاهر للحكمة أن الإفـراط في الحب مذموم، والاعتدال فيه محمود، وقريب من هذا المعنى حديث "أحْببْ حَبِيبَكَ هَــوْنًا مَا عَسَى أنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَــوْنًا مَا عَسَى أنْ يَكونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا" صحَّحه الألباني، ونَسَبَه البعض لسيدنا عليٍّ، ويُستثنَى من هذا المعنى أن المؤمن مأمور بالحب التام للإيمان والبُغض التام للكفر، كما أنه مأمور بحسن المعاملة بــرًّا وعـدلا مع أي إنسان مُسالِم لم يظلمه ولم يقاتله في الدين ولا الوطن والأرض مهما كان اعتقاده.
ــ والمراد من الحكمة أن الإفــراط في الشيء تجاوز وانحراف، والاعتدال فيه هو الخير كله؛ لذا وصف الله الأمة بالوسَطية، قال تعالى: {وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}، فالوسَط هو العدل والاعتدال والتوازن، وبهذا الوسَط سنكون شهداء للأنبياء على أقوامهم يوم القيامة؛ قال تعالى: {لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} وقد ورد هذا المعنى العظيم في خمسة مواضع بالقرآن: أولها: في وصف بقرة موسى: {قَالَ إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لاّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} فارض مُسنَّة، وبكر صغيرة، وعوان وسَط، والمراد أنها بقرة متوسطة السنِّ بين الكبر والصغر.
ــ والموضع الثاني في طعام كفارة اليمين: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}، أي إذا اختار المُكفِّر الإطعامَ فليكن إطعامه من متوسِّطِ إطعام أهله منه نوعا وكما وكيفا، فلا يُطعمهم مِن أعلاه، ولا يطعمهم من أدناه، والتوسط هو الاعتدال، ولو جمع عشرة مساكين فغـدَّاهم أو عشَّاهم كفاهُ ذلك.
ــ والموضع الثالث في الإنفاق: {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىَ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مّحْسُورا} مغلولة: مقيدة، والمراد البخل الشديد، وهو مرفوض، وعُبِّر عنه باليد؛ لأنها مصدر العطاء والمنع، قال تعالى: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ}، و{كُلّ الْبَسْطِ} تعبير عن التبذير وهو مرفوض؛ لأنه من صفات الشياطين، قال تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}، وقوله: {فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا} بيان لجزاء الشُّح والتبذير؛ لأن البخيل يبغضه الناس، والمبذر يبغضه ورثته.
ــ والموضع الرابع في قـراءة القرآن: {وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً}، المراد بالصلاة الدعاء أو قراءة القرآن في الصلاة، وكان النبي في مكة إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبُّوا الله والنبي والقرآن، فنزلت الآية تأمر النبي ألا يرفع صوته كثيرا حتى لا يسمعه المشركون، وألا يخافت بالقراءة فلا يسمعه أصحابه، إنما يبتغي بينهما سبيلا، وهو الوسط في القراءة والدعاء ليسمعه أصحابه ولا يسمعه المشركون.
ــ والموضع الخامس في مدح عباد الرحمن: {وَالّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} الإسراف الإفراط، والقتر الضيق، والقوام الوسط، والمراد أنهم معتدلون في الإنفاق، وبذلك يتحقق الاستقرار والنهوض المجتمعي؛ لأن الإنفاق ضروري وإلا وقفت حركة الحياة، والاعتدال فيه منفعة للفـرد والمجتمع؛ إذ يحقق ارتقاءً ذاتيا واجتماعيا؛ لأن الإنسان باعتداله يدِّخر بعض ماله فيرتقي به، وينفق بعضه فتنمو حركة الحياة، فيرتقي المجتمع.
ــ وقد ذمَّ الإسلام الغـلـوَّ ومدح الاعتدال في كل شيء حتى العبادة، فوصف القرآن الرهبنة في العبادة بأنها بدعـة؛ قال تعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ}، وقال النبي: "إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ"، ونفى النبي عن نفسه صفة التكلُّف، قال القرآن على لسانه: {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ}، وفي الحديث "هَلَكَ المُتنَطِّعُونَ" أي المتكلّفون، و"آخَى النَّبيُّ بيْنَ سَلْمَانَ وأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً (رثّة الهيئة غير مهتمة بزينتها)، فَقَالَ لَهَا: ما شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أخُوكَ أبو الدَّرْدَاءِ ليسَ له حَاجَةٌ في الدُّنْيَا، فَجَاءَ أبو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ له طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، قَالَ: فإنِّي صَائِمٌ، قَالَ: ما أنَا بآكِلٍ حتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فأكَلَ، فَلَمَّا كانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أبو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كانَ مِن آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ، فَصَلَّيَا فَقَالَ له سَلْمَانُ: إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فأعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فأتَى النبيَّ فَذَكَرَ ذلكَ له، فَقَالَ النَّبيُّ: صَدَقَ سَلْمَانُ"، هذا الحديث يعكس لنا وسطية الإسلام، وهو ما ذكره القرآن في قوله تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا}.












 القبض على متهم بالتعدي على مسنة أمام مسجد بالمحلة الكبرى
القبض على متهم بالتعدي على مسنة أمام مسجد بالمحلة الكبرى ارتفاع ضحايا حادث تصادم بمحور 30 يونيو في بورسعيد إلى 18 وفاة...
ارتفاع ضحايا حادث تصادم بمحور 30 يونيو في بورسعيد إلى 18 وفاة... ضبط 433 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
ضبط 433 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الداخلية تضبط أكثر من 101 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
الداخلية تضبط أكثر من 101 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 - 2 - 2026
أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 - 2 - 2026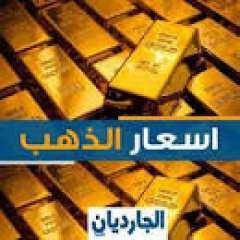 أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يقفز 40 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يقفز 40 جنيهًا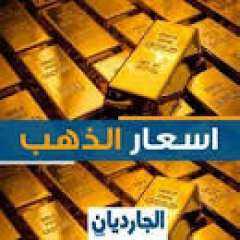 ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 7200 جنيه الجمعة...
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 7200 جنيه الجمعة... الدولار ينخفض 5 قروش أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري بالتعاملات الصباحية
الدولار ينخفض 5 قروش أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري بالتعاملات الصباحية