شبراوى خاطر يكتب : ”الشعرة” ودورها في السياسة والقيادة والعلاقات الإنسانية..


كان لكلمة "شعرة" نصيب وافر من الشهرة في التراث العربي..
إنها مصطلح "شعرة معاوية" وهي عبارة اصطلاحية أصبحت من الأمثال الدارجة على ألسن الناس، يُقصد منه الموقف غير الثابت، والذي يتبدل بين اللين والشدة بناء على موقف الطرف الآخر، من أجل إبقاء الوضع في المنتصف. ومنشأ هذا المثل هو ما يُنسَب "لمعاوية بن أبي سفيان" أول الخلفاء الأمويين في الدولة الأموية. والتي كان قيامها بعد عصر الخلافة الرشيدة حادثاً جللاً بالغ الخطر في تاريخ الإسلام، وتاريخ العالم كما وصفه عملاق الأدب العربي "عباس محمود العقاد".
حينما سُئل كيف حكمت الشام أربعين سنة رغم القلاقل والأحداث السياسية المضطربة، قال:
"لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت"
أو كما قيل: يُحكى أن أعرابيا سأل معاوية بن أبي سفيان: كيف حكمت الشام أربعين سنة ولم تحدث فتنة والدنيا تغلي؟ فأجابه معاوية: إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي، ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني. ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، كانوا إذا مدوها أرخيتها، وإذا أرخوها مددتها.
وكما ذكر بعض المراقبون والدارسون للشئون العامة: تحوّلت «شعرة معاوية» من منهجية سياسية إلى موقف أو أسلوب اجتماعي متعدد المواقف، فيقال أن فلاناً من الناس يستخدم شعرة معاوية إذا كان يبدل مواقفه ويحاذر المصادمة. وكذلك، مازالت العبارة تظهر في عناوين الصحف السياسية وعلى ألسن المحلّلين لتصف سياسات الدول خارجياً وداخلباً. وتوسعت العبارة حتى أصبحت تطال مجالات مختلفة تظهر فيها نفس الفكرة.
وتُستخدم بشكل غير مباشر كذلك في استراتيجيات مهنة العلاقات العامة، فعندما نحلل أنواع ووضعية الجماهير ذات الصلة بالمؤسسات والشركات، فنبحث عن الخط المتصل بين المؤسسة والجمهور، من أجل خلق التفاهم المتبادل، وتعزيز التوافق والقبول، والعمل بفعالية وكفاءة وتدبير على ألا ينقطع هذا الخط أو لنقل "الشعرة" حيث من النادر أن توجد علاقات متبادلة ثابتة بشكل جيد طوال الوقت وإنما تتفاوت وتتغاير درجة شدتها و مرونتها وليونتها. حسب الظروف والأحوال والأهواء وتصارع المصالح.
هذه الشعرة هي الأشهر في التاريخ السياسي، والتي غيرت الكثير من استراتيجيات العلاقات الإنسانية والسياسية وأحد أهم تكتيكات علم التفاوض ومهاراته.
وقد كان هذا المبدأ من أسباب رسوخ وإزدهار واستمرار توسع الخلافة الإسلامية في عهد الدولة الأموية، وهذا التوجه العقلي يؤكد لماذا أُعتبر" معاوية بن أبي سفيان" داهية من دهاة العرب الأذكياء، ومن أوفرهم حظاً في السياسة، والذي بقي في الخلافة تسع عشرة سنة، استطاع في خلال هذه الفترة الطويلة أن يضع للحكومة الإسلامية أسساً قوية وأن يؤسس دولة وطيدة الأركان ثابتة الدعائم. وأخذ يعمل على تأليف قلوب العرب ونشر الإسلام، نقل عاصمة الخلافة إلى دمشق وجعلها وراثية في ذريته، وأمر ببناء أول أسطول بحري عربي ووجهه لمقاتلة البيزنطيين، توفي بدمشق سنة ٦٠ هجرية، وكان في الثامنة والسبعين من عمره.
وبالحديث عن الدهاء، فيقول الاستاذ العقاد في كتابه "معاوية بن أبي سفيان": بأن الدهاء أصبح كفؤا للشجاعة أو راجحاً عليها في موازين الصفات الاجتماعية.
وأن رواة التاريخ العربي يحدثوننا عن دهاتهم في صدر الإسلام فيقولون إنهم أربعة: عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبه، وزياد بن أبيه، ومعاوية بن أبي سفيان، ويقولون إن ابن العاص للبديهة، والمغيرة للمعضلات، وزياد لكل كبيرة وصغيرة، ومعاوية للروّية.
لذا فقد أجمع مؤرخوه من مادحيه بأن "معاوية" أُشتهر بالدهاء والحلم، وكما قال عنه 'قبيصة ابن جابر': "صحبت معاوية فما رأيت رجلاً أثقل حلماً ولا أبطأ جهلاً ولا أبعد أناة منه"
ومثال على مدى حلمه الممزوج بالدهاء الذي ينبغي أن يدرس في صفوف العلوم السياسية والاسترانيجية كما جاء في خطبة له ذات يوم:
"والله لا أُحسن السيف على من لا سيف له، وإن لم يكن منكم إلا ما يستشفى به القائل بلسانه فقد جعلتُ ذلك دُبر أذني وتحت قدمي".
فكان حدّ الحلم عنده ألا يكون في العدوان والتطاول مساس بملكه وسلطانه: أغلظ له رجل فأكثر فقيل له: أتحلم عن هذا؟ فقال:
"إني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا".
أقول قولي هذا وأنا أتعجب كيف لا يتم تدريس سيرة هذا الداهية وأسلوبه في الحكم والإدارة في كل أكاديميات القيادة والإدارة والسياسة، بدلاً عن الاستناد الى كتاب "الأمير" لنيكولا مكبافيللي والذي جاء بعد معاوية بأكثر من ثمانمائة وخمسون سنة، فربما استفاد من دهاءه وحلمه في وضع كتابه الذي يُقال أنه موجود تحت وسادة كل ملك وحاكم وقائد حول العالم.
وعلى امل ألّا نقطع الشعرة التي بيننا وبين تراثنا.












 القبض على متهم بالتعدي على مسنة أمام مسجد بالمحلة الكبرى
القبض على متهم بالتعدي على مسنة أمام مسجد بالمحلة الكبرى ارتفاع ضحايا حادث تصادم بمحور 30 يونيو في بورسعيد إلى 18 وفاة...
ارتفاع ضحايا حادث تصادم بمحور 30 يونيو في بورسعيد إلى 18 وفاة... ضبط 433 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
ضبط 433 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الداخلية تضبط أكثر من 101 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
الداخلية تضبط أكثر من 101 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 - 2 - 2026
أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 - 2 - 2026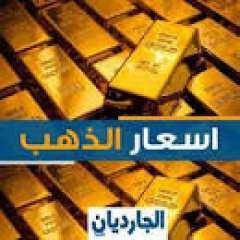 أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يقفز 40 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يقفز 40 جنيهًا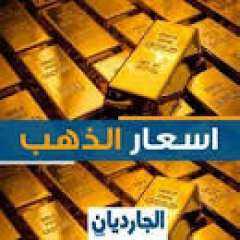 ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 7200 جنيه الجمعة...
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 7200 جنيه الجمعة... الدولار ينخفض 5 قروش أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري بالتعاملات الصباحية
الدولار ينخفض 5 قروش أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري بالتعاملات الصباحية