المحلل السياسى محمد الشافعى يكتب : القتل والتجويع الممنهج....صمت عالمي أمام مأساة شعب أعزل


في القرن الحادي والعشرين، حيث تُرفع شعارات حقوق الإنسان، والكرامة، والعدالة، لا يزال شعب فلسطيني أعزل من السلاح يُقتل، ويُجوع، ويُشرد على مرأى ومسمع من العالم.
ورغم التقارير اليومية، والصور المؤلمة للأطفال الذين تسقط أشلاؤهم تحت أنقاض المنازل، والرضع الذين يموتون جوعًا أو اختناقًا أو نقصًا في الأكسجين، تبقى ردود الفعل الدولية مجرد "استنكار" و"إدانة" لا تترجم إلى فعل حقيقي يوقف جريمة الحرب المستمرة منذ عقود.
إسرائيل، الدولة الوحيدة في العالم التي تُمارس سياسة القتل والتجويع كوسيلة منظمة لإخضاع شعب بأكمله، تواصل عدوانها الممنهج على قطاع غزة والضفة الغربية. قتل الرضع، ونسف المستشفيات، وتدمير المدارس، وقطع الكهرباء والماء والغذاء عن ملايين المدنيين، كلها ليست "أخطاء وقعت بالصدفة"، بل جزء من استراتيجية معلنة تهدف إلى إبادة جماعية بطيئة، تُدار بدم بارد ودعم صريح من قوى عظمى.
القتل الممنهج: عندما تُستهدف الحياة نفسها
أعداد الأطفال الذين قُتلوا في قطاع غزة خلال العدوان الأخير تفوق أعداد الجنود في بعض الحروب.
رضع لم يبلغوا شهرهم الأول، وصغار لم يعرفوا بعد معنى الحرب، يُقتلون بقصف مكثف على منازلهم، أو يموتون داخل ملاجئهم من الجوع أو الأمراض. المستشفيات، التي يفترض أن تكون مناطق آمنة، تُستهدف وتُقصف، ويُمنع دخول الأدوية والمعدات الطبية. أطباء يجاهدون لإنقاذ حياة المرضى دون ماء أو كهرباء، بينما تُقطع سبل النجاة بحجة "الأمن".
العالم يرى، ويسمع، ويُصوّر... لكنه لا يتحرك.
التجويع كسلاح حرب
فرض الحصار على قطاع غزة ، تحول إلى أداة قتل جماعي. أكثر من مليوني إنسان يعيشون في مساحة ضيقة، تُحظر منهم المواد الأساسية: الغذاء، الدواء، الوقود، مواد البناء، وحتى البطاريات. هذا الحصار، الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه "أكبر سجن مفتوح في العالم"، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب
التجويع ليس مجرد حرمان من الطعام، بل هو سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة شعب، وإفراغ أرضه من سكانها، وفرض واقع جديد بالقوة. . ومع ذلك، لا تُتخذ أي إجراءات جادة من قبل المجتمع الدولي لرفع هذا الحصار غير الإنساني.
صمت عالمي... وتمثيلية إنسانية
المؤسسات الدولية، من الأمم المتحدة إلى منظمات حقوق الإنسان، تصدر بيانات "تُدين" وتُستنكر. لكن هذه البيانات لا تُترجم إلى عقوبات حقيقية، ولا حظر للسلاح، ولا تجميد لعلاقات دبلوماسية. بل إن بعض الدول التي تُطالب بوقف الحرب تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تُستخدم في قتل الأطفال.
المظاهرات في الشوارع، والشعارات في المدن الأوروبية والأمريكية، وإن كانت تعبر عن تضامن حقيقي، تُقابل بالتجاهل من قبل صناع القرار. . لا توجد عقوبات اقتصادية، لا حظر للواردات، لا إدانة في مجلس الأمن تُترجم إلى فعل .. بل على العكس، تُستخدم الفيتو لحماية إسرائيل من أي مساءلة.
هل هذا هو العالم في القرن الحادي والعشرين؟
سؤال يفرض نفسه: هل هذا هو العالم الذي نعيشه؟ عالم تُقصف فيه المستشفيات، وتُقتل فيه الأمهات مع أطفالهن، وتُدمر فيه البيوت على رؤوس سكانها، بينما تُعقد الندوات، وتُصدر البلاغات، وتُرفع الشعارات... دون أن يتغير شيء؟
هل يمكن لدولة أن ترتكب جرائم حرب يومية، وتُدمر مدنًا، وتقتل أطفالًا، وتعيش في منأى عن العقاب، فقط لأنها تمتلك دعمًا سياسيًا وعسكريًا من القوى العظمى؟
الإجابة الصادمة هي: نعم.
هل من منقذ؟
الشعب الفلسطيني لا يطلب الشفقة، بل يطلب العدالة .. يطلب أن يُعامل كإنسان له حق في الحياة، في الأرض، في الحرية. يطلب من العالم أن يتوقف عن التمثيلية، وأن يُترجم الإدانات إلى خطوات عملية: وقف توريد الأسلحة، فرض عقوبات، محاسبة المجرمين، ودعم حق العودة.
العالم اليوم يُحاكم بضميره. . فهل سيستيقظ قبل أن تُمحى آخر صورة لطفل فلسطيني يموت في حضن أمه تحت الأنقاض؟ أم أن صمتنا سيكون شاهدًا على واحدة من أبشع الفصول في تاريخ الإنسانية؟
في النهاية، لا يمكن لأي دولة أن تكون فوق القانون، ولا يمكن لأي شعب أن يُسلّم بمصيره تحت القصف والجوع .. يجب أن ينتهي هذا الكابوس .. يجب أن يُسمع صوت الضمير.
فالعدالة لا تُبنى بالكلمات، بل بالأفعال.
والفعل المطلوب اليوم ليس أقل من وقف هذه المجزرة، ومحاسبة من يقف وراءها، وضمان حياة كريمة لشعب ظُلم طويلا حتى من خلال قياداته المتناحرة سواء فى منظمة التحرير أو فتح أو حماس أو غيرها مما يسمون أنفسهم مقاومة .


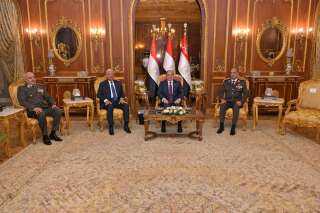









 تأجيل محاكمة 139 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 9 مايو
تأجيل محاكمة 139 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 9 مايو إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ربع نقل بجوار موقف الأقاليم بإسنا
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ربع نقل بجوار موقف الأقاليم بإسنا القبض على متهم بالتعدي على مسنة أمام مسجد بالمحلة الكبرى
القبض على متهم بالتعدي على مسنة أمام مسجد بالمحلة الكبرى ارتفاع ضحايا حادث تصادم بمحور 30 يونيو في بورسعيد إلى 18 وفاة...
ارتفاع ضحايا حادث تصادم بمحور 30 يونيو في بورسعيد إلى 18 وفاة... أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 - 2 - 2026
أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 - 2 - 2026 أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يقفز 40 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يقفز 40 جنيهًا ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 7200 جنيه الجمعة...
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 7200 جنيه الجمعة... الدولار ينخفض 5 قروش أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري بالتعاملات الصباحية
الدولار ينخفض 5 قروش أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري بالتعاملات الصباحية