الكاتب الصحفي إسماعيل أبو الهيثم يكتب : طرح في غير محله ، وبيان لم يشف صدور المتسائلين !!


فوجئت كما فوجئ غيري بحديث متلفز لقناة عربية يستضيف الأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر لسؤاله عن كيفية عن كيفية توزيع تركة أسرة مات عائلها وترك ولد وبنتين ، وفي معرض اجابته عن السؤال السهل والذي لا يحتاج لأستاذ دكتور للإجابة عليه ، قال : بأنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث إذا تم الإتفاق علي ذلك ، وهو ما أحدث جدلًا واسعًا وصل في بعضه إلى وصم الدكتور الهلالي بأنه ليس مجتهدا ولايملك أدوات الإجتهاد ، وليس فقيها ولايصلح لذلك ، ويتبع الشواذ من الآراء .......الخ ، الأمر الذي حدي بالأزهر الشريف الي إصدار بيان جاء فيه : أن علم المواريث في الإسلام علم دقيق ومحكم تولى الله عز وجل تقسيمه في القرآن، لأهمية العدالة فيه ومنع النزاعات، وأن نصوص الميراث قطعية غير قابلة للاجتهاد أو التعديل بإجماع الصحابة والعلماء، ومناسبة لكل زمان ومكان. وأن تجديد الفكر الديني لا يتم عبر الشاشات أو من غير المتخصصين، بل هو حرفة دقيقة لا يُتقنها إلا العلماء الراسخون داخل المؤسسات العلمية، محذرًا من أن الفكر المتطرف في طرفيه — الجمود أو التفلت — يؤدي إلى ذات النتيجة: تضييع الدين وأحكامه. وأن التشكيك في أحكام الدين لا يصدر إلا عن طاعن متغافل عن الطبيعة التعبدية للشريعة، مشددًا على أن المسلم الحق هو من يسلم لحكم الله وتشريعه، معتبرًا إياها افتئاتًا على الشرع وولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف.
كنت أتمني عدم إصدار هذا البيان ، علي أن يدعي الدكتور الهلالي إلي لجنة البحوث الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية لمناقشته فيما قال ، والوقوف علي الأسباب الحقيقية التي دفعته لإثارة هذا الموضوع ، وعن مدي قانونية إعلان ذلك .
مرجع اعتراضي علي إصدار البيان يكمن في أن الرجل القائل بالتسوية أستاذا في جامعة الأزهر ، ( كما أعلن أنه استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ،( وليس سابقا) وبذلك نكون قد اعطينا الفرصة الذهبية لمن يتربص بالأزهر ويعمل بدأب علي جره الي واديهم ليكون مضغة في أفواه الكارهين والمتربصين !!
كنت أتمني أن يلملم هذا الخلاف في المجالس العلمية المغلقة ، باحثين عما ينفع الناس ويحقق صالحهم ويراعي متغيرات الحياة وأزماتها الطاحنه .
شخصيا لا أدعي القدرة على الحكم علي الدكتور الهلالي ، ولا حتي تفنيد رأيه !! فمحركي الوحيد لكل مقال أكتبه أو جدل أخوضه في القضايا الدينية، هو إما أن أكون ندا حين الرد ، أو أشاهد لأتعلم !!
كل ما أريد قوله : بأنني مقتنع بالمنظومة التشريعية ككل - التي أرستها الشريعة الإسلامية في ميراث الأنثى ، لما لها من اعتبارات عادلة شاملة ، فهناك حالات ورثت فيها المرأة كما الرجل تماما ، وهناك حالات ورثت هي ولم يرث هو ، وحالات أخرى زاد فيها نصيبها عن الرجل .
ولم ترث المرأة على النصف من الرجل سوى في أربع حالات لها أسبابها العادلة والمعقولة،لأنها في مقابل إعفائها من تبعات يتحملها عنها إما والدها أو أخوها أو زوجها أو أحد عصبتها الذكور .
ولاأريد أن أخوض هنا في تفصيلات ليس هذا المقال محلها ، فمحلها هو البحث العلمي ، أو مجالس التعلم والفقه لاغير ، غير اني في نفس الوقت أري أن بيان الأزهر المقتضب خلا من التأصيل العلمي الذي يجتث كل ما وقر في قلب كل من أعجب أو مال إلي ما قاله الدكتور الهلالي !!
وكنت أود أن يمثل الدكتور الهلالي أمام لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية للمناقشة استبيانا للحقيقة العلمية ، فإن اتفقا فبها ونعمت !! وإن اختلفا احتكما لهيئة كبار العلماء ، بعيدا عن المنازلة علي صفحات الرأي العام أمام العوام ، لاسيما وان للعلم حرم لا ينبغي أن يخرج علي غير اهله !!؟
أما أن يقتصر رأي الأزهر علي بيان لم يجب بوضوح عما يتحدث به القائلون بالتسوية من تساؤلات ، مثل : هل الميراث من الأحكام الاجتماعية أم من الشعائر التعبدية ؟
هل هو من المعاملات أم من العبادات أو العقائد الأساسية.؟
هل الإرث مسألة اجتماعية تخضع في منطق الإسلام لقيم الحياة المجتمعية في إطار مقاصد الشريعة ومبادئها وبما يحول المساواة فيه لغرض شرعي يدعو له؟و هل المساواة في الميراث تعتبر من مقاصد القرآن في تحقيق العدل الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة ، أم لا ؟
وإذا سلمنا جدلاً أن الميراث " مبدأ اجتماعي واقتصادي من مبادئ توزيع الثروة " ثابت ديني، هل كيفية تقسيم الميراث ثابتة دينيا أيضاً ؟
وهل لا يجوز الإجتهاد في فقه المواريث علي الرغم من أن الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في بعض مسائله ، حين وجدوا أنفسهم أمام مشكلات تقتضي هذا الاجتهاد، ومنهم سيدنا عمر --رضي الله عنه -- في أكثر من واقعة ، بل وأخذ اجتهاده هذا صفة الحكم القضائي وقتها ، مثل قضائه رضي الله عنه بالتشريك بين الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في المسألة الحجرية المعروفة ، بعد اعتراض الإخوة الأشقاء على قضائه الأول بعدم توريثهم .
هناك فريق يري أن الحكم الشرعي الناتج عن النص القطعي ثابت في أصله لايتغير ، ولكن الإجتهاد التنزيلي لهذا الحكم على واقع المكلفين يرتبط بخطاب الوضع من أسباب وشروط وموانع ، مما يجعل الحكم التنزيلي هذا متغيرا بتغير حال المكلف وأوضاعه الحياتية والمعيشية والظروف الزمانية والمكانية والبيئية بل والعالمية التي تحيط به .
وما الرد علي من يقول : بأن المواريث لم تكن حكما قاطعا من أول وهلة، وإنما تدرّجت أحكامها على سبع مراحل، مابين العهد المكي والعهد المدني علي النحو التالي:ـ
في بداية الإسلام، في( الفترة المكية) ، كان الميراث أساسه الحِلف والنُّصرة حتى مع اختلاف الدِّين. فكان بعض المشركين المتعاطفين مع المسلمين يوفرون حماية قَبَلية لهم بموجب الإعلان عن الموالاة أو النصرة، فيحترم المشركون تلك الحماية. وبموجب هذه الموالاة، يدخل كلا الرجلين مع أهل الآخر في الميراث، فيقول أحدهما للآخر: “أنت وليّي، ترثني وأرثك”. ولذلك كان المسلم يرث من غير المسلم، والعكس أيضا إن كان بينهما موالاة ونصرة، قال تعالي : “ولكلٍّ جَعَلْنَا مَوالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إن الله كان علي كل شيء شهيدا” (سورة النساء الآية ٣٣). وقد بقي هذا الحكم إلى بداية الفترة المدنية، حيث كان المسلمون في المدينة يتوارثون مع من بقي من المسلمين في مكة ولم يهاجر، أو مع مواليهم من المشركين.
ثم تغيّر الحكم، بعد فترة قصيرة من الهجرة، فكان الإرث بالإسلام والهجرة فقط. ، قال تعالي: “وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا”. وبهذه الآية، انقطعت الولاية بين المؤمن المهاجر وغيره، ممن لم يُؤمن، أو آمن ولم يهاجروا....""سورة الأنفال الآية ٧٢"
ثم تغير الحكم مرة ثالثة، فأصبحت الولاية للقرابة والرحم فقط في سورة الأنفال: “وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ, والله بكل شيء عليم " " سورة الأنفال الآية رقم ٧٥
إذن نلاحظ التدرج:من الميراث على أساس الولاية والنصرة بين المسلم والمشرك، أو بين المسلم والمسلم، إلى الميراث على أساس الإسلام والهجرة فقط، إلى الميراث على أساس القرابة والرحم. وهذا كله مفهوم ومنطقي جدا، بحيث يمهد إلى تأسيس الدولة، وتركيز ثروة المسلمين المهاجرين في دار الهجرة بالمدينة.
في مستوى ثانٍ من التدرج، نلاحظ أنه في البداية لم يكن هناك نظام مقدّر للميراث، فتُرِك للرجل لبضع سنوات بعد الهجرة، أن يُوزع ماله قبل موته كما يشاء:”كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتقِينَ” (سورة البقرة الآية رقم ١٨٠)
ولكن الرجال، بحكم أعرافهم القَبَلية، عمدوا إلى تخصيص بعضٍ دون بعض بالوصية. فكانوا يخصّون الرجال دون النساء. فنزل الوحي: “لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْه أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا” (سورة النساء الآية رقم ٧ ).فأصبح نصيب المرأة فرضا وليس اختيارا. ومع ذلك، لم يبيِّن نصيب كل وارث، وترك ذلك لتقدير الناس.
وبعد فترة، تولَّى القرآن توزيع التَّرِكة ، قال تعالي:”يُوصِيكُمْ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ…” ( سورة النساء الآية رقم ١١ )، “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ…” ( سورة النساء الآية رقم ١٢)، وقال تعالى : “يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ…” ( سورة النساء الآية رقم ١٧ ). فبيَّن نصيب الأصول والفروع، ثم نصيب الزوجين، ثم نصيب الإخوة والأخوات.
وكان حظ الأنثى يراعي كونها لا تنفق على نفسها، وإنما الرجل هو الذي ينفق عليها. فراعى القرآن في التوزيع جعل حظِّ الذَّكَر مثل حَظِّ الأنثيين إذا كانت هناك مساواةٌ في الدرجة، ومشاركةٌ في سبب الإرث؛ لأن الأنثى لا تنفق على نفسها، إن كانت بنتًا أو أُمًّا أو زَوْجَة، وإنما نَفَقَتُها في الأعم الأغلب على غيرها. وهذا التقسيم للميراث يجعلها في بعض الحالات يزيد نصيبها على الذَّكَر أو يتساوى معه عند اختلاف الدرجة."
هذا هو إذن التدرج الذي حصل في أحكام المواريث على سبع مراحل. ومقارنة هذه الأحكام بأوضاع الأمم الأخرى قبل الإسلام، تنفي قطعيا تهمة امتهان الإسلام للمرأة في أحكام الميراث. بالعكس، فإن أي منصف سيرى فعلا أن هناك اتجاها تصاعديا وواقعيا في تحسين الوضع الاجتماعي للمرأة، ومنح المرأة حق التصرف المالي. وتقسيم المواريث الذي استقر عليه الأمر في آخر النبوة يبدو هو الأعدل بالنظر لوضع المرأة في ذلك السياق. وربما لم يستوجب الأمر التدرج إلى حد المساواة بين الذكر والأنثى.
كل هذا يبين أنّ أحكام الميراث تتكيف مع البيئة والظروف الاجتماعية، بما يحقق العدل.
فهل إذا تغير الواقع الاجتماعي، هل يكون من حرج في مواصلة التكيف معه (على نفس المنهج) مع المحافظة على المقصد القرآني في أحكام المواريث، وهو حفظ الحقوق وإقامة العدل.!!!؟
وهل النسبة المقررة للذكر والمقدرة له بنصيب الاثنتين وفقا لحجم وعمق وكنه الدور الذي يقوم به ، من تفرغه للعمل علي قضاء شؤون الأسرة ، فإذا ما أصبح هذا الدور غير
قائماً على تفرغ الرجل للعمل خارج البيت، وتفرغ المرأة للعمل داخل البيت، بحيث لم يعد الرجل وحده ينفق على البيت، وإنما حتى المرأة تنفق على البيت. فهل يوجد حرج في إعادة النظر في أحكام المواريث وتكييفها بحيث يمكن المساواة بين المرأة والرجل في الميراث؟؟
وهل نموذج القوامة الذي كان هو النموذج الاجتماعي القائم عند نزول الوحي ، باعتبار أن الرجل كان هو الذي يعمل ويوفر الرزق، والمرأة متفرغةً في البيت لرعاية الأسرة. وبهذا المنطق، فتوريث المرأة النصف بدون أن يُطلب منها الإنفاقُ من مالها لا يمثّل ظلما لها ، بينما يعطي للرجل ضعف ميراث المرأة ويطالبه وجوبا بالإنفاق منه عليها وعلى بقية أسرته.
أما في عصرنا، وقد تغير النموذج الاجتماعي والاقتصادي جذريا، وأصبحت المرأة تعمل تماما مثل الرجل خارج البيت، وبالتالي، فهل يجوز فهم آيات الميراث على ضوء هذا التغير الاجتماعي. وليس في هذا إنكار للنص القرآني وإنما فهم مقاصدي له في سياقه!!؟
كلها أطروحات وتساؤلات منطقية لابد أن تطرح علي مائدة ( كبار العلماء) للحوار بعيدا عن الأحكام المسبقة والاتهامات المتبادلة ، وقبل كل هذا إزالة الحاجز النفسي بين النخب العلمية والفقهية والاجتماعية ، في إطار تطوير فهمنا البشري للنص القرآني.
و هناك أيضا إشكالية يجب أن تزال ؛ فهناك من يري أن أحكام المواريث ينظر فيها للمقاصد الاجتماعية، وأن آيات المواريث جاءت لتصحيح وضع اجتماعي جاهلي كان يحرم المرأة من الميراث، باعتبار أن القبيلة العربية كانت تمنح الإرث للابن الذكر الأكبر سنا في العائلة، أو للشجاع المقاتل في الحروب. وللوارث بعد ذلك أن يوزع التركة حسب رغبته على إخوته وأمه وأقاربه. وجاءت المواريث لعلاج حالات وسيناريوهات اجتماعية واقعية في عصر النبي في مجتمع المدينة، والأصل أن يقوم الفقهاء بإعمال الاجتهاد حين تتغير أحوال المجتمع.
ونريد أن نقدم راي يشفي صدر أي متسائل عن كيفية قبول أغلب المسلمين بإنفاق المرأة على نفسها وبالمشاركة في الإنفاق على الأسرة، وفي بعض الأحيان تكون هي العائل الوحيد للأسرة لسبب من الأسباب، رغم وجود نصوص صريحة في القرآن (شبيهة بآيات المواريث) على وجوب إنفاق الرجل على المرأة؟ فهذا يعني أنّ من يقبل بنفقة المرأة على أسرتها في مجتمعنا الحديث نظرا لصعوبة الواقع الاجتماعي رغم وجوب النفقة على الرجل حسب النص القرآني، يجب أن يقبل المساواة في الميراث لنفس الأسباب.!!؟؟
أزعم أنها تساؤلات لها منطقها . ويمكن الجدل العلمي حولها.!!
تبقي كلمة .
لا اتفق البتة مع الدكتور الهلالي في طرح أي اجتهاد علمي ( علي أحسن تعبير ) علي وسائل التواصل الاجتماعي ، وألفت نظره إلي ضرورة الاصطفاف العلمي خلف مؤسسته (الأزهر الشريف ) وليس معني ذلك التوقف عن الإجتهاد ، وانما يولد الإجتهاد ويناقش في الأزهر ثم يحصن بمجموع الآراء تفاديا للأحادية ، واعارضه في المطالبة بعمل استفتاء شعبي علي أمر ديني او قضية تحتاج لإقرارها إلي انفتاح ذهني علي الآراء ودراسة هادئة لزوايا النظر المختلفة، واستدللاتها وحججها المنطقية، وتبعاتها الإجتماعية والاقتصادية، في فترات التغيير الجذري للواقع، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المصلحة المجتمغية دون المساس بالثوابت الدينية.
في النهاية.
ألا يستحي كل من في ذمته ميراث لأخته أن يأخذه ظلما وجورا علي ماهو عليه، من أن حقها نصف حقه ، ألا ماذا كان سيفعل إذن إن تساوت الأنصبة . أترك لكل قاريء أن يتوقع ماذا يحدث حينئذ!!؟












 القبض على متهم بالتعدي على مسنة أمام مسجد بالمحلة الكبرى
القبض على متهم بالتعدي على مسنة أمام مسجد بالمحلة الكبرى ارتفاع ضحايا حادث تصادم بمحور 30 يونيو في بورسعيد إلى 18 وفاة...
ارتفاع ضحايا حادث تصادم بمحور 30 يونيو في بورسعيد إلى 18 وفاة... ضبط 433 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
ضبط 433 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الداخلية تضبط أكثر من 101 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
الداخلية تضبط أكثر من 101 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 - 2 - 2026
أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 - 2 - 2026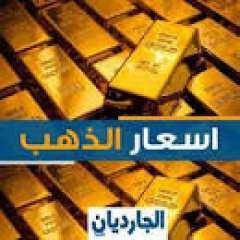 أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يقفز 40 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يقفز 40 جنيهًا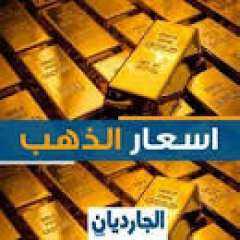 ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 7200 جنيه الجمعة...
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 7200 جنيه الجمعة... الدولار ينخفض 5 قروش أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري بالتعاملات الصباحية
الدولار ينخفض 5 قروش أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري بالتعاملات الصباحية