الإعلامى الكبير محمد جراح يكتب : بين الثقافة والسياسة ونوستالجيا الواقع والأوهام


قد لا يبالغ في القول من يدعي أن المصريين مروا على مدار تاريخهم الطويل بكثير من الشدائد والمحن، وتسلط على شأنهم بعض ممن يسكن في رأسه الشطط، ولا يقف هذا الأمر على عصر دون آخر فكثيرة هي المرات التي تأذى فيها الناس؛ ليخرجوا من كربهم مهما طال أو امتد وقد ذهب ذلك الذي شط أو تجبر فسكنت سيرته الأقبية، وطوى صفحاته المعتمة التاريخ. ويستطيع المتتبع لتاريخ مصر خلال القرون الثلاثة الأخيرة أن يلاحظ أن المصريين ظلوا محرومين من الحق في المعرفة لأنهم كانوا خارج دائرة القرار خلال تلك الحقب التاريخية التي عانوا فيها من تسلط السلطة الحاكمة فالويل كل الويل لمن يشق عصا الطاعة والعقاب الغاشم ظل سيفاً مشرعاً على رقاب من يعكر صفو السلطات وخير مثال على ذلك ما مرت به مصر طوال العصر المملوكي الذي تولى فيه أمر البلاد أجيال من المماليك أي العبيد الذين كانوا يباعون في أسواق النخاسة في آسيا وأوروبا، ومن عجب أنهم تميزوا على أبناء البلاد لما صار الأمر كله في أيديهم في غياب شبه تام للشعب الذي عانى الكثير من عنتهم وتسلطهم، ومن بعدهم سار على الوتيرة نفسها كل من المستعمرين الفرنسي والانجليزي.
ومن النوادر التي يحكيها التاريخ أن الصعود السريع للمماليك في دولاب الإدارة كان دافعاً لكثيرين من شباب أوروبا وآسيا للدخول في الاسترقاق طوعاً من أجل المجيء إلى مصر التي صارت في ذلك التاريخ قبلة للطامحين والحالمين بالحكم في بلد الشعب غائب فيه عن القرار. وقد لا يكون الأمر مستغرباً والحال هكذا من حيث الميزات والوجاهة التي يحصل عليها المملوك أن يقدم أحد الشباب المصريين ليدخل نفسه في التجربة حتى يقع في الاسترقاق وينال من الحظوة والوجاهة ما يناله المماليك، وقد سافر ذلك الاب بالفعل ناحية الأناضول، ونجح في إيقاع نفسه في الاسترقاق، وجاء إلى مصر على أنه مملوك تركي له ما للمماليك من ميزة، وقد انطلت حيلته على السلطان "قايتباي" لكنه بدا عجولاً إذ لم يمر عليه وقت طويل بعد ارتدائه البزة العسكرية حتى طلب الزواج، كما زل لسانه فتحدث بلهجة ولسن المصريين فانكشف أمره.
نوستالجيا الواقع والأوهام
بين يدي كتاب للدكتور محمد فتحي عبد العال يحمل عنوان "نوستالجيا الواقع والأوهام" يقول في تقديمه له إنه استمرار لما بدأه من قبل في كتاب آخر يحمل عنوان "صفحات من التاريخ الأخلاقي في مصر" ناقش فيه موضوع تصحيح حالة المثالية المتعلقة بالماضي ورجالاته. ويعرض الكتاب في أبوابه الأربعة عشرة كثيراً من مظاهر الحياة المصرية في القرون الثلاثة الأخيرة، وضرب أمثلة كثيرة للتدليل بعضها يعود إلى القرن التاسع عشر، وأكثرها يعود إلى القرن العشرين. وإذا كان المؤلف قد سرد كثيراً من القصص والحكايات الطريفة لبعض أهل الحكم والمثقفين طوال تلك الفترة الطويلة فإن الأمر لم يخل كذلك من إشارة إلى عموم الشعب لكنها كانت إشارات مبتسرة بشكل ملحوظ هذا إلى جانب ما حفل به الكتاب من حكايات لبعض مشاهير المجتمع المصري.
العداوة للثقافة
وقد أولى الكاتب في معظم صفحات الكتاب علاقة أولي الأمر المتأزمة مع الثقافة والمثقفين جل عنايته، وساق لنا أمثلة حية لتلك العلاقة المتوترة بين الطرفين، وكيف كانت الثقافة وأربابها على الهامش في معظم الأحيان، بل ولا ينظر إليها أو إليهم بما يستحقونه من إجلال وإكبار، فظلت الثقافة شيئاً ثانوياً في عقول كثير من السياسيين الذين ربما رأوها ترفاً لا يستحق الاهتمام، على الرغم من أن الثقافة السياسية نتاج شرعي للثقافة بشكل عام والتي هي أي الثقافة العامة مجموعة القيم المجتمعية التي تشمل العادات والتقاليد والمعتقدات وتؤدي إلى حراك يفضي إلى نهضة تشمل فيما تشمله الحراك السياسي الذي يؤدي إلى زيادة في الوعي والمعرفة التي تفيد في المسيرة الديمقراطية سواء بالمشاركة في الأنشطة الحزبية أو المشاركة في الانتخابات وغيرها من الاستحقاقات التي يتمتع بها مجتمع ما دون آخر.
وربما رأى المسئولون أن الثقافة تؤدي إلى وعي؛ وهذا الوعي سيقود إلى زيادة في المعرفة وهذه المعرفة ستؤدي إلى نقد ما يشوب المسيرة السياسة من عوار وذلك في الوقت الذي تتمايز فيه السياسة على غيرها، ولا تتردد في التسلط على الثقافة لردها إلى الأطر التي تمكن صاحب القرار السياسي من تنفيذ رؤيته التي تعتمد على الحس العملي والملاحظة التجريبية بعيداً عن أي خيال أو مثالية قد تشوب رؤى الثقافة وأربابها. ولا يعني ذلك انه كانت توجد نهضة ثقافية بما تعنيه كلمة نهضة ولكن كانت هناك أصوات كثيرة وقامات كان بإمكانها متى أعطيت الفرصة أن تكون سنداً للسياسي في النهضة المجتمعية، لكن سياسة التربص ظلت هي الحاضرة في معظم الأحيان. والغريب أن من تولى الأمر من الأجانب المستعمرين سلكوا المسلك ذاته فتسلطوا وتربصوا بالثقافة وكيفوا التعليم بما رأوه يحقق لهم مصالحهم، ولا أدل على ذلك من أن التعليم تكبل بقيود لا تمكنه إلا من تخريج مجموعة من الكتبة والمترجمين ليكونوا تحت إمرة المحتل الانجليزي، كما تعنتت بريطانيا عندما أقدمت مصر على إنشاء الإذاعة المصرية ولما رضخت ووافقت وضعت الكثير من الشروط والعراقيل التي تكبل تلك الوسيلة من أداء دورها المجتمعي بالشكل الأمثل، بل وتشاركوا في الإدارة والرقابة. ومثال آخر على العنت الانجليزي ما كان يصرف من رواتب ومكافآت للموظفين الانجليز العاملين في الإدارة المصرية، ولنا أن نعرف أن المستشار من الإنجليز كان يحصل على راتب سنوي يزيد على ألفي جنيه، بينما قرينه المصري لا يتجاوز مرتبه مائتي جنيه طوال العام، وبالطبع لا توجد نسبة ولا تناسب بين الرقمين الانجليزي والمصري.
عدو الثقافة
وإذا كان الكتاب قد تحدث في كل شيء وزاده في ذلك التاريخ إلا أننا نلاحظ أنه أولى العلاقة المتأزمة بين الثقافة والمثقفين وبين السياسة والسياسيين عناية ملحوظة، فجعل من تلك المادة مدخلاً إلى كتابه المنوع في موضوعاته الكثيرة التي دارت في عصور المماليك والاحتلال وانتهاء بالحقبة الخديوية والملكية التي كانت فيها البلاد ما تزال محتلة. وقد ضرب لنا مثلاً بالنظرة المرتبكة من جانب اسماعيل باشا صدقي" الذي شغل منصب رئيس الوزراء بملامح السياسي البرجماتي، فألقى بالضوء على تلك الشخصية بما سكنها من صفات ما يمكن تسميتها بصفات الديكتاتور الواقعي، أو المستبد صاحب البصيرة، وسنجد ونحن نتصفح الكتاب أن صدقي ظل يخالف الإجماع دائماً، وظل يخسر بدكتاتوريته التأييد الشعبي ظناً منه أنه يسير على طريق الصواب، وأنه يعمل من أجل المصلحة العامة، ولذا ومادام الحال هكذا فلا صوت يعلو على صوته؛ لأنه صوت المصلحة كما ظل يظن!.
اليد الحديدية
آمن اسماعيل باشا صدقي بما كان يعتقده بأن حلول قضايا الوطن لا تنجزها الشعارات، ومضى في غلوه فرأى الأمة المصرية أمة غير مؤهلة للديمقراطية، ولا المباشرة سلطة حكم ذاتها بعيداً عن سلطة أبوية تحدد لها معالم الطريق، وقد بالغ فوصف الشعب المصري بأنه شعب كل حكومة، وباستطاعته هو تشكيل الحاضر وفق رؤيته وبما يسكنه من قناعات دونما اعتبار لأي إرادة شعبية وللتدليل على قناعاته نراه يصرح بأنه إذا تم اختياره لذلك المنصب الخطير - أي منصب رئيس الوزراء - فستكون سياسته هي محو الماضي بما له وما عليه، ويبالغ فيقول إنه سينظم الحياة السياسية بما يتفق ورأيه في الدستور وكان الماضي الذي يقصده هو ثورة 1919م، وهو الماضي الذي ظلت الأمة المصرية تحصد ثماره في مقاومة المستعمر، وفي إنجاز وضع دستور للبلاد عام 1923م.
ومن بين مظاهر تسلطه وتشبثه بوجهة نظره موضوع دفن رفات زعيم الأمة سعد باشا زغلول؛ فقد عرقل دفنه في الضريح الذي أقيم بعد جدال ونقاش مجتمعي طويل حول حجم وشكل بناء الضريح، فقد كان من رأي البعض أن يأتي تصميم بناء الضريح على الطريقة والطابع الإسلامي، بينما رأى غيرهم أنه من الأفضل أن يأتي في شكل فرعوني، وقد تم تبني الرأي الأخير، ولما أنجز المبنى رأى "صدقي" أنه لا يليق إلا بنقل المومياوات المصرية القديمة التي كانت كائنة متحف بولاق لتوضع فيه.
وقد ظل "صدقي" كارهاً لليبرالية المصرية؛ ومتربصاً بأي حراك يصدر عنها، وعلى سبيل المثال أمر قوات الشرطة بهدم السرادق الذي أقامه السيد "حمد" "الباسل" عميد قبيلة "الرماح" في مديرية الفيوم للاحتفال بالمجاهد الليبي "عمر المختار"، بل إنه بالغ في عنجهيته فلم يكتف بأمر تقويض السرادق بل أمر بمحاصرة المنزل الذي سيشهد الاحتفال حتى لا يدخله أحد على الإطلاق، وزاد فأمر قوات البوليس بوضع الأسلاك الشائكة في الطريق حتى تعطل قدوم السيارات وغيرها من وسائل الانتقال في ذلك التاريخ وقد استقر في رأسه أن الاحتفال إن تم فإنه يعد جرماً سياسياً يستحق منه ما قرره بشكله الذي تم. ويمضي الكتاب فيصفه بأنه كان ديكتاتوراً كارهاً للديمقراطية حتى وإن لم يكن شأن البلاد كله في يده باعتباره كان الرجل الثاني في السلطة التنفيذية بعد الملك فؤاد، فنراه يعمل على ترسيخ سلطة الملك المطلقة، وهو من أدار أزمة تنازل الخديوي عباس حلمي الثاني عن العرش لصالح الملك فؤاد وكان المال هو ثمن سكوت "الخديوي عباس"؛ فتم الاتفاق على أن يصرف له سنوياً مبلغ ثلاثين ألف جنيه طوال حياته، ولا ينتقل ذلك إلى أولاده، وكان عباس قد خلع من العرش أثناء وجوده في تركيا وقت اندلاع الحرب العالمية الأولى، وقد رأت بريطانيا التخلص منه لما صار يبديه من ملاحظات، وبما أصبح يسعى إليه من أجل نهضة بلده، كما أن السلطات المحتلة امتعضت منه جراء حادثة قرية "دنشواي" ورأت بعين المستعمر المتغطرس أنه لم يفعل ما كانت تراه واجباً عليه أن يفعله؛ فادخرت العقاب حتى موعده الذي جاء والخديوي خارج البلاد؛ فتم خلعه عن الحكم بما يوضح كيف كان حكام مصر من السلاطين والملوك ضعفاء أمام جبروت المحتل الذي لم يكتف بما وقع على أهالي القرية من ظلم تمثل في إعدامات من أدانتهم المحكمة ظلماً، وفي حبس وتنكيل بالأبرياء، بل عوقبت القرية نفسها فسحبت منها كينونتها واستقلالها فتم إلغاء منصب العمدة فلا تكون القرية كياناً قائماً بذاته؛ بل تلحق على قرية تجاورها شأنها في ذلك شأن التوابع والنجوع، كما عوقبت الحكومة في شخص ملاحظ نقطة شرطة مدينة الشهداء "مراد أفندي محرم" الذي أتهم بالتقاعس ففصل من وظيفته؛ كما تم فصل خفراء القرية وصولاً إلى خلع الخديوي كما سبق التوضيح.
التصادم مع المثقفين
استحق اسماعيل صدقي لقب عدو الشعب الذي أطلقوا عليه عموم الناس، وقد بادله الشعب الكراهية، وكانت سماته الشخصية تجعله يضيق بالثقافة وقد أحاط نفسه بالمنافقين الذين يدافعون عنه ويصدون أي هجوم عليه، بل ويتطوعون فيبادرون بتشويه كل يتعرض له مثلما هو الحال الآن في اللجان والكتائب الإعلامية المأجورة التي تملأ الفضاء الإلكتروني وتهاجم وتشوه كل من يتعرض بمن يدفع لها مقابل عمالتها ودفاعها.
والواقع أن معظم كبار الكتاب والمفكرين والمثقفين عموماً لم يسلموا من تسلط اسماعيل صدقي، وكمثال على تلك العلاقة الملتبسة مع الثقافة والمثقفين تم حبس الكاتب والمفكر الكبير "عباس محمود العقاد" لمدة تسعة أشهر بتهمة العيب في الذات الملكية سنة 1930م، وكان الرجل قد علق في البرلمان الذي كان عضواً فيه على رفض قانون محاسبة الوزراء، لكن صدقي أول كلامه على أنه عاب في ذات الملك فأدين وحبس على الرغم من كونه كان نائباً بمجلس النواب، وهو أي العقاد الذي لم ينل حظه السياسي كما كان يتوقعه ويريده، فلم يكن باشا، ولا كان وزيراً، في حين حصل عبد القادر حمزة رئيس تحرير "البلاغ" على الباشوية دونما جهد مثل جهود العقاد الذي مدح الملك فاروق بأبيات منها:
وما اتخذت غير فاروقها عماداً يجاد وركناً يؤم
ولا عرفت مثله في العلا صديقاً يشاركها في القمم.
ومن الطريف أن عباس محمود العقاد تغير كلية، واتقلب بدرجة 180 درجة على العهد الملكي بعد قيام ثورة يوليو عام 1952م.
كما شابت علاقته بالدكتور "طه حسين" التوتر منذ مجيئه عميداً لكلية الأداب سنة 1930 م خلفاً للفرنسي "ميشو"، وقيل إن سبب ذلك التوتر هو رفض الدكتور طه حسين منح الدكتوراه الفخرية لعدد من السياسيين الذين لا صله لهم بالأدب كما رفض أن تمنح الدرجة لصدقي نفسه، ولم يتوقف رفض طه حسين" عند هذا الحد بل إنه رفض أن يكون رئيساً لتحرير جريدة الشعب لسان حال حزب الشعب الذي أنشأه صدقي باشا، وعلى الرغم من كل تلك المواقف القوية لطه حسين يسوق لنا المؤلف مثالاً على سعيه للشهرة وهو ما يزال في مقتبل عمره من خلال مهاجمة الكبار والأعلام مثل مهاجمته لمصطفى لطفي المنفلوطي والشيخ رشيد رضا بإيعاز من الشيخ عبد العزيز جاويش الذي كان له فضل عليه في موضوع سفره لاستكمال دراسته في فرنسا. ولم تنته مشاكل العميد مع السلطة السياسية وقد انتقلت في تلك المرة من رئيس الوزراء إلى الملك نفسه فقد تصادف أن كان الملك في زيارة لكلية الأداب، وهناك استمع إلى محاضرة في التاريخ عن تطور الدستور الانجليزي وقد جاءت المحاضرة في الوقت الذي عطل فيه الملك ورئيس الوزراء العمل بالدستور، فظن الملك أن الأمر بالشكل الذي تم كان مدبراً، وأن المسئولية تقع على عاتق العميد، ولأن صدقي لا يعرف سوى الانتقام تم عزل الدكتور "طه حسين" من عمادة الكلية، ونقله ليعمل مستشاراً في ديوان عام وزارة المعارف، ولما رفض د. طه حسين تنفيذ القرار تم فصله نهائياً من الخدمة، فقامت المظاهرات التي احتجت على قرار الحكومة لكنه لم يعد؛ وإن كان الشعب أطلق عليه لقب عميد الأدب العربي من يومها؛ ربما عوضاً عن منصب عمادة كلية الآداب الذي أقيل منه. وقد استقدم صدقي الدكتور أحمد الاسكندرني أستاذ الإنشاء والأدب العربي بكلية دار العلوم" ليحل محل طه حسين وكان من مؤسسي مجمع اللغة العربية، كما كان عضو لجنة اعتماد الرسم العثماني لطباعة المصحف الشريف، ووضع قواعد الوقف وغيرها، أي أنه أصاب في اختياره لتلك الشخصية العلمية الثرية، أما الطرفة في الموضوع أنه كان هناك من اتهم طه حسين بخدمة الأدب اليوناني القديم والاستشراق اكثر من خدمته للأدب العربي، ولم يتردد مؤلف الكتاب في إعلان انحيازه إلى قرار اسماعيل صدقي بعزل طه حسين.
كما لم يسلم الصحفي الكبير محمد التابعي من ملاحقة صدقي فتم حبسه لمدة أربعة أشهر في إحدى القضايا التي سخر فيها منه، كما سجن محمد توفيق دياب صاحب جريدة "الجهاد" لما نشر تسريباً لخطابات من صدقي لأقسام البوليس التي يأمرهم فيها بتزوير أصوات الناخبين لصالح مرشحي حزب الشعب الذي يترأسه، كما خاض دياب حملة ضده بسبب بناء سد جبل الأولياء" في السودان بما تكلفه من أموال طائلة كما قال.
أما الشاعر محمود أبو الوفا صاحب قصيدة "عندما يأتي المساء" التي لحنها وتغنى بها الموسيقار محمد عبد الوهاب فقد امتحن في شبابه ببتر ساقه اليسرى، فسعى البعض إلى رئيس الوزراء لكي تتكفل الدولة بسفره إلى فرنسا لتركيب ساق صناعية له هناك، وقد طلب من توسطوا في الأمر أن يمتدح الشاعر رئيس الوزراء بقصيدة أو بعدة أبيات شعرية، لكن الشاعر رفض ذلك العرض الذي يطلب حقاً له بنفاق المسئول، غير أن الشاعر سافر بالفعل للعلاج، ولكن لا توجد معلومة مؤكدة تقول لنا: هل وافق له إسماعيل صدقي فسافر على نفقة الدولة، أم أن السيدة هدى شعراوي" هي التي تكفلت بالعملية كما قالت روايات أخرى؟ ومن أبو الوفا إلى الموسيقار رياض السنباطي الذي رفض أن يحيي حفلاً حضره صدقي مما جعله هدفاً لهجوم الاله الإعلامية المناصرة لسيادته. وقد ظل صدقي عدواً لدوداً لمن يهتم بالثقافة، ولم تتأخر الرائدة النسائية "منيرة "ثابت" في الكتابة عن عهده وما شابه من تسلط واعتداء على حقوق الإنسان وتزويره الفج للانتخابات النيابية لصالح حزبه إلى الدرجة التي جعلت شاعر النيل حافظ إبراهيم يدعو عليه بقصيدة يقول في مطلعها:
ودعا عليك الله في محرابه
الشيخ والقسيس والحاخام.
علاقته بالشيوعيين والأمراء
كان شديد القسوة معهم وقد عزز قانون العقوبات سنة 1946م بعدة مواد أضيقت خصيصا للقضاء على ما يسمى بالشيوعية فقاد حملة اعتقالات لأدباء اليسار ومنهم: سلامة موسى ومحمد مندور، كما أغلق عدداً من الصحف منها الفجر الجديد والجبهة والضمير والوفد المصري، ولم يتأخر في مزيد من القيود ومنها سحب الجنسية من الذين يظن انتمائهم إلى التنظيمات الشيوعية من المصريين الذين يعيشون في الخارج حتى الأمراء لم يسلموا منه ومنهم الأمير عباس حليم نصير الحركات العمالية وزعيم العمال فقد حبسه الملك بإيعازه؛ وجرده من لقب "النبيل" الذي يحمله، وقد دفعت مواقفه السلبية تجاه المثقفين لأن يشكلوا أول جمعية لحقوق الإنسان في مصر لتقف في وجه التجاوزات والإعتداءات المتكررة عليهم.
ومن نافلة القول نذكر عنه أنه أصر على استبدال الحرف العربي بالحرف اليوناني على غرار التجربة التركية وقام بعرض مشروعه على جلستي مجمع اللغة العربية في 31، 24 من يناير عام 1944م، ومن الطريف أنه قال عن الحروف العربية إنها حروف وثنية سواء أكان مصدرها النبطيون في الشمال، أو البمنيون في الجنوب، بينما رأى الحرف اللاتيني حرفاً كتابياً لأنه حرف لغة المسيحيين وهم أهل كتاب، بل ومضى فقال إن اللغة العربية ليست لغة واحدة، وإنها عدة لغات تداخلت واندمجت ورأى ان رسم القرآن ليس مأموراً به، وغير ذلك من الأفكار التي كان يبتدعها وينبري للدفاع عنها في محاولة لفرضها وتطبيقها.
الأيادي البيضاء
لا يذكر التاريخ موقفاً كان صدقي مناصراً فيه للقضايا الثقافية إلا استقالته على أثر قضية كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ علي عبد الرازق حيث استقال في البداية "عبد العزيز باشا فهمي" وزير الحقانية أي العدل، وتبعه صدقي الذي قيل ان الملك هو من أقاله لتقاعسه في اتخاذ موقف وإجراء عقابي تجاه مؤلف الكتاب فكانت استقالته تعضيداً لموقف صديقه الوزير، والحزب الأحرار الدستوريين الذي يتزعمه ذلك الوزير. كما كانت له إنجازات أخرى في التنمية ومنها بناء كوبري اسماعيل الذي عُرف فيما بعد باسم كوبري قصر النيل، ومن الغريب أن المعارضة هاجمته بسبب اتساع عرض الكوبري بمقاييس ذلك التاريخ، ورأوا في ذلك الاتساع تبذيراً وإهداراً للمال العام، كما أنشأ مجلس مكافحة الفقر والجهل والمرض، وبنى سد جبل الأولياء على النيل الأبيض السودان في الفترة من 1933 وحتى 1937م وكان ماؤه كله لصالح مصر.
كتاب "نوستالجيا الواقع والأوهام" للكاتب محمد فتحي عبد العال كتاب مليء بكثير من حكايات التاريخ، كما أنه لا يخلو من الطرائف والغرائب مما لا يتحمله هذا العرض الذي ركز بشكل أو بآخر على العلاقة المتوترة بين المثقف والسلطة.












 القبض على متهم بالتعدي على مسنة أمام مسجد بالمحلة الكبرى
القبض على متهم بالتعدي على مسنة أمام مسجد بالمحلة الكبرى ارتفاع ضحايا حادث تصادم بمحور 30 يونيو في بورسعيد إلى 18 وفاة...
ارتفاع ضحايا حادث تصادم بمحور 30 يونيو في بورسعيد إلى 18 وفاة... ضبط 433 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
ضبط 433 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الداخلية تضبط أكثر من 101 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
الداخلية تضبط أكثر من 101 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 - 2 - 2026
أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 - 2 - 2026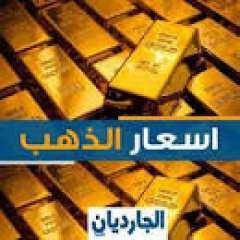 أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يقفز 40 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يقفز 40 جنيهًا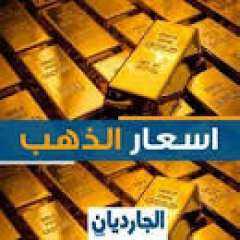 ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 7200 جنيه الجمعة...
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 7200 جنيه الجمعة... الدولار ينخفض 5 قروش أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري بالتعاملات الصباحية
الدولار ينخفض 5 قروش أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري بالتعاملات الصباحية