الدكتور علاء الحمزاوى يكتب : فأوغلوا فيه برفق !!


ــ ما أخطر الغُـلوَّ على المرء والمجتمع! إنه يؤدي إلى التطرف والانحراف وزعزعة الاستقرار؛ لذا نهى الله أهل الكتاب عن الغُـلوِّ قائلا: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ}، وكان غلـوُّهم أنهم جعلوا بعض أنبيائهم أبناءً لله فهلكوا؛ جاء في الحديث «إِيَّاكُم والغُـلوَّ في الدِّينِ فإنما أهلَك مَن كان قبلَكم الغُـلوُّ في الدِّينِ»، وهنا ندرك عظمة الإسلام؛ فقد جاء موصوفا بالعدل والاعتدال في كل شيء عبادة وعلاقة ومعاملة، قال تعالى: {وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}، وَسَطًا: خيرا وعـدْلا واعتدالا، والناس: الأمم السابقة، وتُعَــدُّ الوسطية أحـد مظاهر الفضل الإلهي على الأمة، فهي أمـة الصراط المستقيم وأمـة أفضل قبلة وأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمـة العـدل والخير؛ فهي أفضل الأمم؛ ومن ثم فهم شهداء على الأمم يوم القيامة، ففي الحديث «يُجاءُ بنُوحٍ يَومَ القِيامَةِ، فيُقالُ له: هلْ بَلَّغْتَ؟ فيَقولُ: نَعَمْ يا رَبِّ، فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ: هلْ بَلَّغَكُمْ؟ فيَقولونَ: ما جاءَنا مِن نَذِيرٍ، فيَقولُ: مَن شُهُودُكَ؟ فيَقولُ: مُحَمَّدٌ وأُمَّتُهُ، فيُجاءُ بكُمْ فَتَشْهَدُونَ»، نشهد بصدق نوح؛ لأن القرآن أخبرنا أن نوحا أمر قومه بعبادة الله، وكذلك باقي الأنبياء، أما شهادة النبي على الأمة فهي تصديق لشهادتها على صدق الأنبياء في تبليغ دعوتهم.
ــ هذه هي أمة الاعتدال الذي كان سلوكا للنبي وأمر به لمَّا قرر بعض الصحابة أن يترهبنوا؛ حيث «جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إلى بُيُوتِ أزْوَاجِ النَّبيِّ يَسْأَلُونَ عن عِبَادَةِ النَّبيِّ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأنَّهُمْ تَقَالُّوهَا (رأوها قليلة)، فَقالوا: وأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبيِّ؟! قدْ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وما تَأَخَّرَ، فقَالَ أحَدُهُمْ: أمَّا أنَا فإنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أبَدًا، وقالَ آخَرُ: أنَا أصُومُ الدَّهْرَ ولَا أُفْطِرُ، وقالَ آخَرُ: أنَا أعْتَزِلُ النِّسَاءَ فلا أتَزَوَّجُ أبَدًا، فَجَاءَ رَسولُ اللَّهِ إليهِم، فَقالَ: أنْتُمُ الَّذِينَ قُلتُمْ كَذَا وكَذَا؟! أَمَا واللَّهِ إنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وأَتْقَاكُمْ له، لَكِنِّي أصُومُ وأُفْطِرُ، وأُصَلِّي وأَرْقُدُ، وأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليسَ مِنِّي»، وهذه قمة الاعتدال والرفق.
ــ لذا كان من وصايا النبي «إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ»، متين: صَلْب، وأوغلوا: بالغوا، والرفق: اللين، والمراد أن الدين قوي راسخ يسع الجميع لا يضره ولا يُضعِفه إفراط شخص أو تفريط آخر، فينبغي على المسلم أن يبالغ في أداء العبادة لتحقيق الكمال فيها دون إفراط ولا تكلُّف؛ لأن التكلُّف تنطُّع وقد «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ»، بل يسير المسلم في عبادته برفق وتلطُّف وتدرُّج، فلو أن شخصًا أراد أن يقوم الليل فلا يبدأ أول ليلة بإحدى عشرة ركعة، إنما يبدأ بثلاث أو خمس ثم يزيد تدريجيا، فالإفراط يؤدي إلى الملل وترك العبادة؛ لأن الشيء إذا زاد عن حــدِّه انقلب إلى ضـدِّه.
ــ وهذا المعنى نجده في حديث «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا»، يُشادُّ: يغـلـو ويغالب في العبادة ليأتي بكل ما أمر به الدين فلن يستطيع، والمراد النهي عن التشدد في الدين بأن يحمِّل الإنسانُ نفسَه من العبادة ما لا يطيق، فمن غــلا وغالب في العبادة غلبتْه فأهلكتْه؛ سمع النبي رجلا يمدح في عبادة رجل قائلا: «إنه من أكثر أهل المدينة صلاة، فقال النبي له: لا تُسمعْه فتهلكه»، أي إذا سمعك تمدحه يزيد في العبادة فيهلك؛ لأنه سيفتُر فيترك العبادة فيهلك بالآثام، ويحتمل أنه يهلك بالرياء، وسدِّدوا: الزموا السداد أي الصواب، وقاربوا: إن لم تصلوا إلى الكمال فاعملوا بما يقرب منه، وأبشروا بالثواب على العمل.
ــ وجاءت نصوص كثيرة تدعو إلى التحلِّي باليُسر والاعتدال في كل شيء، كقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}، و{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ}، وفي الحديث «يا أيُّها النَّاسُ خُذُوا مِنَ الأعْمَالِ ما تُطِيقُونَ؛ فإنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتَّى تَمَلُّوا، وإنَّ أحَبَّ الأعْمَالِ إلى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وإنْ قَــلَّ»، وفي الحديث «بَشِّروا وَلا تُنفِّروا، ويَسِّروا وَلا تُعسِّروا، وسَكِّنُوا- ولا تُنَفِّرُوا»، والتسكين إدخال الطمأنينة على الناس، وما أعظم قول النبي: «إذا أمرتُكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم»، فهل هناك تيسير أعظم من أن يقيّـدَ اللهُ طاعتَه بالاستطاعة قائلا: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}؟! ذلك لأن الاستطاعة مناط التكليف، والمشقة تجلب التيسير، ومن مظاهر التيسير الرُّخَصُ في العبادات كالجمع والقصر في الصلاة والفطر في رمضان للمسافر والمريض والإعفاء من الزكاة والحج لغير القادر، هذا هو إسلامنا الذي اصطفاه ربنا فقال: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}، فما أعظمه من دين!












 القبض على متهم بالتعدي على مسنة أمام مسجد بالمحلة الكبرى
القبض على متهم بالتعدي على مسنة أمام مسجد بالمحلة الكبرى ارتفاع ضحايا حادث تصادم بمحور 30 يونيو في بورسعيد إلى 18 وفاة...
ارتفاع ضحايا حادث تصادم بمحور 30 يونيو في بورسعيد إلى 18 وفاة... ضبط 433 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
ضبط 433 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الداخلية تضبط أكثر من 101 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
الداخلية تضبط أكثر من 101 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 - 2 - 2026
أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 - 2 - 2026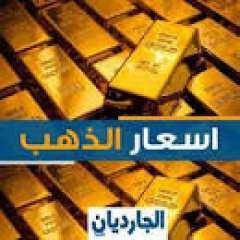 أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يقفز 40 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يقفز 40 جنيهًا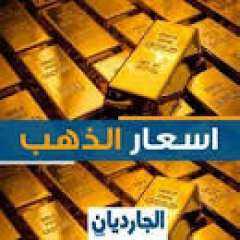 ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 7200 جنيه الجمعة...
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 7200 جنيه الجمعة... الدولار ينخفض 5 قروش أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري بالتعاملات الصباحية
الدولار ينخفض 5 قروش أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري بالتعاملات الصباحية